أنتلجنسيا المغرب:عبد الفتاح الحيداوي
مقدمة
شهد العقدان الأخيران تحولا جذريا في المشهد التنظيمي
والاجتماعي، كان العالم الرقمي محركه الأساسي. هذا التحول لم يترك الحركات
الإسلامية بمنأى عنه، بل وضع نموذجها التنظيمي التقليدي، القائم على الهرمية
المغلقة والتربية المباشرة، أمام تحد وجودي. إن سؤال راهنية الأساليب التنظيمية
التقليدية للحركات الإسلامية ليس سؤالًا عن الوجود من عدمه، بل هو سؤال عن تغير
الوظيفة والفعالية. ففي الوقت الذي أدى فيه الفضاء الافتراضي إلى تقليص دور هذه
الأساليب في الاستقطاب الجماهيري، فإنه لم يلغِ ضرورتها، بل أعاد تعريف أهميتها في
سياقات أخرى أكثر عمقاً وحساسية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل هذا التحول، وتحديد
الوظائف الجديدة التي باتت تضطلع بها الأساليب التقليدية، وصولاً إلى اقتراح نموذج
تنظيمي هجين يمثل مسار البقاء والتأثير لهذه الحركات.
أولاً: التحدي الرقمي وتقليص دور الاستقطاب الجماهيري
لقد مثل ظهور الإنترنت ومنصات التواصل
الاجتماعي نقطة تحول حاسمة في آليات العمل الحركي. ففي السابق، كانت الأساليب
التقليدية —من اجتماعات سرية، وحلقات تربوية، ومخيمات شبابية، وأنشطة اجتماعية
مباشرة— هي القناة الرئيسية لـالاستقطاب الجماهيري. كانت هذه الأساليب تضمن وصولا
منظما ومحكوما إلى الأفراد، وتخضعهم لعملية فرز وتأهيل تدريجية.
ومع ذلك، أدى العالم الرقمي إلى تحدي
النموذج الهرمي المغلق 1. لقد وفرت المنصات الرقمية بيئة مثالية لـ"الانتشار
الرقمي" السريع وغير المكلف. أصبح
بإمكان الحركات الإسلامية، أو الأفراد المنتسبين إليها، نشر أفكارهم ومحتواهم
الأيديولوجي لجمهور واسع وعابر للحدود دون الحاجة إلى المرور بالبنية التحتية
التنظيمية المعقدة. هذا التحول أدى إلى تقليص دور الأساليب التقليدية في الاستقطاب
الجماهيري لصالح المنصات الرقمية.
حيث لم يعد
الفعل التنظيمي يعتمد فقط على التواصل المباشر أو النشاط الميداني، بل صار جزءا من
فضاء متسع تحكمه الخوارزميات، وسرعة الانتشار، والتفاعلات الفورية.
في النموذج
التقليدي، كان الاستقطاب
الأولي يعتمد على اللقاءات المباشرة، والأنشطة الاجتماعية،
والفضاءات الدينية مثل المساجد، مما جعل العلاقة بين التنظيم والفرد علاقة شخصية
تقوم على الثقة والقرب. كانت الخطوة الأولى في بناء القاعدة التنظيمية ترتكز على
احتكاك يومي يتيح التقييم والفرز، ويجعل الانخراط عملية بطيئة لكنها عميقة الجذور.
أما في
السياق الرقمي، فقد تغير المشهد بالكامل. صار الاستقطاب يتم عبر منصات التواصل الاجتماعي،
والمحتوى الرقمي، والمجموعات الافتراضية المغلقة أو شبه المغلقة. وبات الوصول إلى
جمهور واسع يتم عبر “انبثاقات” رقمية تعتمد على الجاذبية البصرية والرسائل
السريعة، دون الحاجة إلى لقاء مباشر أو معرفة مسبقة. وهكذا تحول التجنيد إلى عملية
أكثر سيولة، وأقل تحكما، وأكثر عرضة لتقلبات المزاج الرقمي.
وفي ما يتعلق
بـ الانتشار،
كان الأسلوب التقليدي يقوم على النشرات المطبوعة، والمؤتمرات، والتنقل الجغرافي،
وهو ما كان يجعل انتشار الأفكار والتنظيمات محدودا بالعوامل اللوجستية والمالية.
اليوم، ألغت الوسائط الرقمية هذه الحدود تقريبا؛ فأصبحت الرسالة التنظيمية قادرة
على الانتقال عالميا في لحظات، وبكلفة شبه منعدمة. لقد تضاعفت القدرة على الوصول،
وتراجعت الحاجة إلى البنية التحتية المادية، وتحول التنظيم إلى كيان قادر على
التواجد في كل مكان دون أن يكون في أي مكان فعليًا.
أما التأثير على الجمهور، فقد
تغير بدوره. في الماضي، كان التأثير يقوم على الاحتكاك المباشر، والحضور الشخصي
للقيادات، والتفاعل الوجاهي الذي يسمح ببناء علاقة وجدانية قوية. لكن في العصر
الرقمي، حل تأثير من نوع جديد: تأثير واسع، لكنه شعبوي، يقوم على الانتشار السريع،
والانفعال الجماعي، وصناعة رأي عام لحظي. هذه “الشعبوية الرقمية” أعادت تشكيل
وظيفة التأثير، فبدل أن يكون عميقا ومستمرا، أصبح سريعا ومكثفا، لكنه هش وغير
مضمون الاستمرار.
إن هذا
التحول من الأساليب التقليدية إلى الأساليب الرقمية لا يعكس فقط تغيرا في الوسائل،
بل يشير إلى إعادة تشكيل
جذري لوظيفة التنظيم نفسها: من بنية هرمية ذات روابط متينة، إلى شبكات
مرنة تتغذى على التفاعل اللحظي. وبينما وفّر العصر الرقمي فرصا هائلة للانتشار
والتأثير، فإنه حمل أيضا تحديات تتعلق بضعف البناء التنظيمي، وهشاشة الانتماء،
وخضوع الرسائل لسلطة الخوارزميات بدل سلطة القيادة.
وهكذا يمكن
القول إن التحول الرقمي لم يغيّر أدوات التنظيم فحسب، بل أعاد صياغة طبيعة العمل
الحركي، ومفاهيم الانتماء، وأشكال التأثير، مما يجعل فهم هذا التحول ضرورة لأي
قراءة معاصرة للحركات الاجتماعية والدينية في زمن الشبكات.
هذا التغيير لا يعني أن الأساليب
التقليدية لم تعد تستقطب، بل يعني أن وظيفتها في الاستقطاب الأولي قد تراجعت لصالح
الفضاء الافتراضي الذي أصبح بوابة العبور الأولى للأفراد نحو الحركة.
ثانياً: الوظائف الجديدة للأساليب التقليدية: العمق
التربوي والتماسك
على الرغم من تراجع دورها في الانتشار
الأولي، فإن الأساليب التنظيمية التقليدية لم تفقد أهميتها، بل انتقلت وظيفتها من
"الكم" (الانتشار) إلى "الكيف" (العمق). لقد أثبتت التجربة أن
الفضاء الافتراضي، بقدر ما هو فعال في التعبئة السريعة، فإنه قاصر عن تحقيق ثلاثة
أهداف تنظيمية حيوية: تعميق الولاء، وبناء النخب القيادية، والحفاظ على التماسك
التنظيمي.
1. تعميق الولاء
الولاء الذي ينتج عن التفاعل الرقمي
غالباً ما يكون سطحياً وهشاً، ويخضع لتقلبات "الترند" الرقمي. في
المقابل، تظل الأساليب التقليدية هي الأداة الوحيدة القادرة على تعميق الولاء 2.
•التربية المباشرة: تعتمد الحركات
الإسلامية على نظام تربوي تقليدي مكثف، يشمل اللقاءات الدورية، والمحاسبة الشخصية،
والمشاركة في الأنشطة الخدمية. هذه العملية تتطلب الاحتكاك المباشر والتفاعل الإنساني العميق الذي لا يمكن محاكاته
افتراضياً.
•بناء الهوية الجماعية: إن الانخراط
في بيئة تنظيمية تقليدية مغلقة نسبياً يساهم في صهر الفرد في بوتقة الجماعة،
وتكوين "هوية تنظيمية" قوية، مما يحول الانتماء العاطفي إلى التزام عملي
راسخ.
2. بناء النخب القيادية
لا يمكن للقيادة أن تبنى عبر الشاشات.
القيادة تتطلب اختبارا عمليا في الميدان، وقدرة على تحمل المسؤولية، والتعامل مع
الأزمات تحت الضغط.
التأهيل النوعي: تتيح الأساليب
التقليدية، مثل "الأسر" أو "الخلايا التنظيمية"، بيئة لـبناء
النخب القيادية 3. يتم فيها تدريب الأفراد على مهارات الإدارة، واتخاذ القرار،
والخطابة، والتعامل مع الجمهور، تحت إشراف مباشر من قيادات ذات خبرة.
القيادة بالقدوة: التربية التقليدية
تضمن انتقال الخبرة والقيم عبر القدوة والمحاكاة، وهو ما يشكل الأساس الأخلاقي
والعملي للقيادة، ويصعب نقله عبر الفضاء الافتراضي الذي يفتقر إلى عمق التجربة
المشتركة.
3. الحفاظ على التماسك التنظيمي
يواجه الفضاء الافتراضي تحدي التجزئة
والتشتت. فبقدر ما يسهل التواصل، فإنه يهدد وحدة الصف بفتح المجال لتعدد الآراء
والمنابر غير المنضبطة.
الضبط والربط: تظل الهياكل التقليدية
هي الضامن لـالحفاظ على التماسك التنظيمي [4]. فهي توفر آليات الضبط والربط،
وتحديد المسؤوليات، وتوحيد المرجعية الفكرية والسياسية.
المرونة في الأزمات: في أوقات الأزمات
أو الملاحقات الأمنية، تثبت الخلايا التنظيمية التقليدية قدرتها على الصمود والعمل
السري، وهو ما لا يمكن تحقيقه عبر الفضاء الافتراضي وحده الذي يسهل اختراقه
ومراقبته.
ثالثاً: النموذج التنظيمي الهجين كضرورة للبقاء
إن الاستمرار في الاعتماد الكلي على
الأساليب التقليدية يهدد الحركات بـالجمود ونهاية عصرها كقوة فاعلة ومؤثرة، بينما
الاعتماد الكلي على الرقمي يهددها بالسطحية والتفكك. المستقبل يكمن في قدرة هذه
الحركات على التكيف وتبني نموذج تنظيمي هجين يوازن بين الانتشار الرقمي والعمق
التربوي التقليدي.
1. مفهوم النموذج الهجين
باتت
التنظيمات الحديثة، سواء كانت سياسية أو دعوية أو حركية، أمام واقع لا يسمح
بالاعتماد على نمط واحد في إدارة أنشطتها أو ضمان استمراريتها. فالعصر الرقمي، رغم
ما يوفره من إمكانات هائلة في الاتصال والانتشار، لا يلغي الحاجة إلى البنية
التقليدية العميقة التي تُنتج القيادة، وتضبط الهوية، وتُحصّن الأعضاء من التشتت.
من هنا ظهر ما يمكن تسميته بـ النموذج
الهجين الذي يدمج بذكاء بين
العمل الافتراضي والعمل المادي، مع تخصيص وظيفة محددة لكل منهما بشكل يجعل كليهما
عنصرًا لا غنى عنه في البناء التنظيمي.
الانتشار الرقمي: من التوسع إلى صناعة الصورة
يمثل الفضاء
الرقمي مجالًا واسعًا وسريعًا للانتشار والتعبئة الأولية، وتكثيف الحضور الخطابي
والإعلامي. يعتمد هذا المكوّن على أدوات التواصل الحديثة مثل المنصات الاجتماعية،
المحتوى الفيروسي، الحملات الرقمية، والمجموعات الافتراضية.
وظيفته
الأساسية هي:
التعبئة
السريعة
الاستقطاب
الأولي
التواصل
الخارجي
وبناء
الصورة الإعلامية
وبذلك يخدم
هذا المكوّن الهدف التنظيمي المتمثل في التوسع .فبدون توسع رقمي قوي،
تفقد التنظيمات القدرة على الوصول إلى جماهير جديدة، كما تضعف قدرتها على إنتاج
صورة مؤثرة تشكّل جزءًا من شرعيتها الرمزية.
. العمق التقليدي: من بناء النخب إلى ترسيخ الهوية
على الجانب
المقابل، يحتفظ العمل التقليدي — رغم تحولات الزمن — بأهمية جوهرية. إذ يمثل
الفضاء الذي تُبنى فيه النخب، وتُصاغ فيه العقيدة التنظيمية، وتُدار فيه القرارات
الاستراتيجية الحساسة التي لا تتحمل هشاشة الفضاء الرقمي.
وظيفته
الأساسية تتمثل في:
التربية
النوعية
تعميق
الولاء
صناعة
القيادات
اتخاذ
القرار الاستراتيجي
العمل
الميداني.
وبذلك يحقق
هذا المستوى الهدف التنظيمي المرتبط بـ الترسيخ،
أي ضمان الصلابة الداخلية والاستمرارية البنيوية. فالتوسع وحده لا يكفي، بل لا بد
من عمق يحفظ الفكرة، ويعيد إنتاجها، ويضمن انسجام الأعضاء مع مشروعها.
من التقابل إلى التكامل: جوهر النموذج الهجين
تكمن قوة
النموذج الهجين في إدراكه أن الرقمي والتقليدي ليسا بديلين عن بعضهما، بل مستويين
متكاملين:
·
الأول يفتح الأبواب،
·
والثاني يحمي البيت.
العمل الرقمي
يخلق الحركة، بينما العمل التقليدي يخلق المعنى. الرقمي يجذب، والتقليدي يربي.
الرقمي يوسع القاعدة، والتقليدي يبني العمود الفقري.
هذا التفاعل
يجعل التنظيم أكثر قدرة على التكيف مع البيئة الحديثة، دون أن يفقد صلابة البنية
التي يحتاجها لضمان الاستمرار وعدم الذوبان.
النموذج
الهجين ليس مجرد دمج تقني بين وسيلتين، بل هو تصور شامل لإدارة الفعل التنظيمي في
زمن مزدوج:
زمن
تتسارع فيه الحركة عبر الفضاء الرقمي، وزمن لا تزال فيه الفاعلية العميقة مرتبطة
باللقاء المباشر والعمل الميداني وبناء الإنسان.
ومن دون هذا
المزيج، إما أن يسقط التنظيم في هشاشة “الانتشار دون عمق”، أو في عزلة “العمق دون
حضور”.
أما
الجمع بينهما فينتج نموذجا أكثر مرونة، وأكثر قدرة على البقاء، وأكثر استعدادا لمواجهة
تحديات الحاضر والمستقبل.
2. آليات التكيف نحو الهجين
يتطلب التكيف
الفعال بين المجالين الرقمي والتقليدي اعتماد آليات واضحة تضمن التكامل بينهما، من
خلال ثلاثة مسارات رئيسية:
1.
جسر
العبور
يقوم
هذا المسار على ابتكار أدوات تحويل فعلي للأتباع الرقميين نحو الانخراط في الهياكل
الميدانية، وذلك عبر تنظيم فعاليات حضورية دورية – مثل المؤتمرات والورشات
واللقاءات التكوينية – تُخصَّص للجمهور الافتراضي بهدف إدماجه تدريجيًا في البيئة
التنظيمية المباشرة، وترسيخ الارتباط بالفضاء الواقعي.
2.
القيادة
الرقمية الواعية
يقتضي
التكيّف أن تتملك النخب القيادية التقليدية كفاءة رقمية واعية تمكّنها من استخدام
المنصات والأدوات الإلكترونية بشكل آمن وفعّال، ليس فقط في نشر الخطاب، بل أيضًا
في إدارة العمليات الداخلية، وبناء قنوات تواصل مؤمَّنة، وتعزيز القدرة على
التوجيه الرقمي المتماهي مع متطلبات العصر.
3.
التخصيص
الوظيفي
تعتمد
المنظومة الهجينة على الفصل الوظيفي الواضح بين الفضاءين: فالمجال الرقمي يجب أن
يتمتع بالمرونة والانفتاح لاستقطاب الجمهور وتوسيع نطاق التأثير، بينما تظل
الهياكل التقليدية فضاءً مغلقًا ومنضبطًا، مخصّصًا للتكوين النوعي وضبط الإيقاع
التنظيمي وحماية الأمن الداخلي.
خاتمة
إن راهنية الأساليب التنظيمية
التقليدية للحركات الإسلامية لم تنتهِ، بل تحولت. فبعد أن كانت الأداة الرئيسية
للاستقطاب والانتشار، أصبحت اليوم الأداة الحيوية لـالترسيخ والعمق. لقد أثبتت هذه
الأساليب أنها ضرورية لـتعميق الولاء، وبناء النخب القيادية، والحفاظ على التماسك
التنظيمي الذي لا يمكن تحقيقه عبر الفضاء الافتراضي وحده.
إن التحدي الحقيقي الذي يواجه هذه
الحركات هو الخروج من ثنائية "التقليد مقابل التحديث" إلى منطق التكامل
الوظيفي. إن تبني نموذج تنظيمي هجين يوازن بين الانتشار الرقمي والعمق التربوي
التقليدي هو مفتاح البقاء. فالحركات التي تفشل في تحقيق هذا التوازن ستواجه حتماً
خطر الجمود والتفكك، لتشهد بذلك نهاية عصرها كقوة فاعلة ومؤثرة في المشهد السياسي
والاجتماعي.
المراجع
[2] "عن التربية فى الحركة
الإسلامية (2-2)" - إضاءات.
[3] "الثقافة الإسلامية في
العصر الرقمي .. ندوة فكرية تبحث..." - إسلام أون لاين.

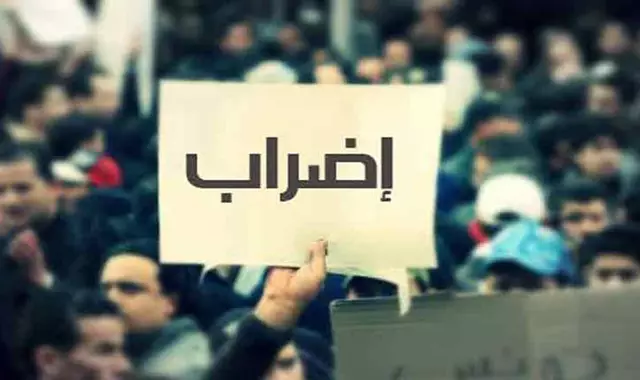


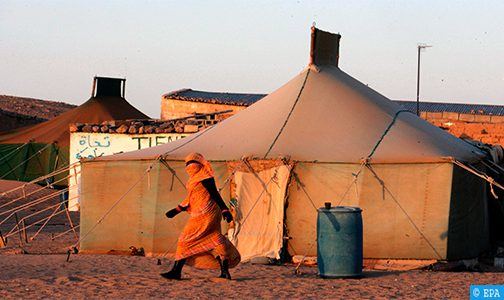
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك