إنجاز: د . الغزيوي أبو علي
د . بن المداني ليلة
مع
نهاية القرن العشرين، انتقل بنا العالم إلى زمن معولم، فلم يعد الإنسان مقياس كل
شيء، حيث تحول إلى جزء في قرية كونية، لم تعد الحواجز التقليدية التي كان يؤمن
بها، ولا الجغرافية التي تشكل الدول والمجتمع، بل انجذب إلى عالم جديد لا يعرف
ضفافه ولا سره، أصبح غريبا كصالح في ثمود، بهذا المعنى غدت الوسائطية كمركز لإنتاج
المعرفة الرقمية وأصبحت الصورة تحكمه في المسافات وفي كل النظريات المجردة، وغدا مجهزا بالرؤية
المتكاملة من أجل برمجة المستقبل، والسؤال المطروح، هل لا زلنا نعيش عصر النقد
الثقافي، قال جمال أبو حمدان: "لقد ألبسنا التجربة التي استحضرناها من الغرب
بعض الملابس العربية، ولكننا لم نستطع حتى الآن أن نعطي ملامح وشكل مسرح عربي داخل
هذه الملابس"، ويستقيم هذا الرأي مع آراء جمهرة عريضة من المشتغلين بهذه
الفنون المستحدثة، لنتذكر ما قاله الطبيب العلج: "تحن بصدد البحث عن
هوية". وانطلاقا من هذا المنهجي، فالنقد اليوم سيشهد بدوره ثورة دراماتيكية،
سواء على المستوى التركيبي أو على مستوى المشهدي لذا أكد محمد بنيس أن الحداثة
حداثات "ونحن جميعا متورطون في الحداثة، وقد أصبحت أثرا من آثار جسدنا، كل
الأطراق وكل القطاعات في المجتمع العربي، ترحل مبتهجة أو يائسة نحو الحداثة"،
ويمكن لأي كان أن يدعي انسلاخه عنها، فالرغبات والمظاهر والنزوعات، جميعها تتحلق
حول لوثة الحداثة، وحتى لا نتوه في المفارقات والمطابقات تنبث في الحداثة حداثات،
والمشترك بينها هو أرضية الغرب، تقنية وفكر وإبداعات، وهذا المشترك في الغرب هو ما
يورطنا جماعيا فيها، مهما تحكمت الخطابات التقليدية على الخصوص في تغيير المسار،
(بنيس محمد: "لمساءلة الحداثة" – مجلة الكرمل – قبرص – ع12 – 1984 –
ص50، 51)، وثمة مراجع كثيرة منها معربة أو موصوفة عن نصوص غربية، أو مطبقة تطبيقا
آليا، على تجارب نقدية درامية عربية، كما هو الحال في غالبية محاولات مجلة
"فصول" (القاهرة) أو "آفاق" (الرباط) أو "الفكر العربي
المعاصر" (بيروت). يقول ألفريد فرج: "نحن لا يمكن أن نكون قانعين بما
أنجزه المسرح العربي، ونود أن نواجه مشاكله الحقيقية في سبيل إرساء هذه التقاليد
المكونة لشخصيته. يقول هاني صنوبر: "طبعا لا، لم يستطع المسرح العربي المعاصر
أن يرسي تقاليد لهوية المسرح العربي"، لأن من الادعاء القول بالإيجاب،
"لأن التقاليد المسرحية لا تنشأ إلا من خلال تراث مسرحي عريق، ونحن أمة لا
تزال جديدة على هذا الفن، وما زال كتابنا وممثلونا ومخرجونا يفتشون عن أنفسهم من
خلال العمل المسرحي"، ويؤكد الآراء السابقة جمال أبو حمدان فيلاحظ أن تجربتنا
"ما زالت حتى الآن تجربة غير عربية في المسرح، وأعود هنا إلى المقولة السابقة
التي تفترض تكاملا اجتماعيا عربيا يعزز ثقافة عربية أصيلة وفي سياقها مسرح عربي
أصيل". يعيد عبد الرحمن بن زيدان إثارة سؤال الغرب بالنسبة لتجربة النقد
العربي الحديث: "اليوم نقول أن الغرب قد طور جهازه المعرفي وأدواته الإجرائية
ورؤيته للإنسان والعالم، لكن أين موقع النقد العربي من هذا المنتج؟ هل هناك علاقة
استهلاك وتبعية؟ أم هنا تجاوز وتحدي هذا المستورد لإضفاء الخصوصيات القومية على
النقد العربي". يقول سمر روحي الفيصل: "يواجه النقد العربي، في هذه
الأيام، مجموعة من الأسئلة الصعبة أبرزها الموقف من المناهج النقدية الأوروبية،
وخاصة صلاحيتها لدراسة الأجناس الأدبية العربية وتحديد علاقة هذه الأجناس بالمجتمع
العربي وبالتراث وبالمبدعات الأوروبية، ووراء هذه الأسئلة نزوع إلى نظرية عربية في
النقد الأدبي هو – في الوقت نفسه – تعبير عن نزوع أشمل إلى تلمس الذات القومية
وتوضيح هويتها المعاصرة"، لذا شغل السؤال النقدي العديد من الباحثين في الجامعات
وخارج الجامعات، وأفرز إشكاليات عديدة هي الآن بصدد المخاض ولاشك أننا نمر الآن
بمرحلة انبهار بما يجد من مناهج نقدية في العالم، ونحاول مواكبتها بقدر المستطاع
ونسعى إلى استيعابها وهضمها وتطبيقها في بعض الأحيان تطبيقا آليا بدوره محاولة
تكييفها لطبيعة إبداعنا لكني متيقن أن كل هذا سيفضي حتما إلى تصور عربي متقارب
يتجاوز ما تقبله، وانبهر به، ويستفيد من التراث العربي، ويخلق حركية ربما أثرت
أيضا في الغير". ويقول علي شلش: "لازال النقد الأدبي في الوطن العربي
اليوم متخذا الطابع القطري، وهذا لا يكفي على الإطلاق، ذلك أن وسائل الاتصال
الحديثة، الكتب والصحافة الأدبية والاتصال الشخصي قد ازدادت بل هي في ازدياد
مستمر، ومعنى هذا أن يواكب النقد الأدبي تطورات النقد العربي على مستوى
القومي". "إلا أن الأخطار التي تهدد النقد العربي الآن تتمثل في عدد من
النقاط أهمها أن بعض النقاد ينجرفون وراء بعض التيارات الأدبية والأمريكية دون أن
يكون ما تبنوه ثمرة جهودهم المتواصلة ودراساتهم المتعددة وبحثهم الطويل وقراءاتهم
المستمرة وبصائرهم الخاصة بل نتيجة الخضوع المفاجئ لما يرونه الآن زيا حديثا جدا
في هذا البلد أو ذاك، من بلدان أوروبا، وبالإضافة إلى أنهم سيضطرون في أية ساعة
مفاجئة لاحقة أن ينطقوا كل ما كتبوه بناء على زي آخر لأنهم أخذوه مقطوعا عن قرائنه
الثقافية والمفهومات الفلسفية والعملية التي نشأ منها، وسوف يتعسفون في استخدامه،
ويقعون في التناقض، نتيجة التناقض الذي لا مفر منه بين ما بقي لديهم من أفكار
فلسفية وعلمية وإنسانية، وهذا المنهج النقدي الجديد الذي اقتحمهم اقتحاما مباغتا.
لذا نظروا إلى الحداثة على "أنها انشغال الفن بنفسه، بمعنى محاولته اكتشاف
هويته ووسائله وأدواته ليتفهم الهدف الذي ينشده، وليتمكن من بدء عملية الهدم
والبناء المعتادة التي رافقت ظهور كل الحركات والمدارس الفنية عبر التاريخ"
(داغستاني، ياسر: الكتابة الروائية والحداثة في مجلة "مواقف" بيروت –
ع:35 – ربيع 1979 – ص97)، يقول إذن: "نحن في العالم العربي، نعيش أزمتين:
أزمة التخلف وأزمة القمع، الكاتب مقموع والقارئ مقموع، وكلاهما يعاني من تخمة
مزمنة في التخلف والكبت والاضطهاد حتى محق الشخصية وإلغاء أي تطلع أو تميز ويعطي
رأي نبيل سليمان فكرة أوسع عن مخاطر تعريف الحداثة بمصطلح آخر، مما يستجيب لأهمية
الحد من نزوع الحداثيين إلى تعريف الحداثة كمجرد فكرة، لقد أشارت أطروحات بعض
الحداثيين المبكرة إلى معنى ارتهان الحداثة داخل منظومتها الثقافية، وإلى تجلي
الحداثة في ممارستها أخيرا، فلا يمكن حقا، تعريف الحداثة، كفكرة، أو للتعمق أكثر
كأفق لآفاق عن نفسها تدريجيا" (لوفيفر هنري: ما الحداثة؟ - ترجمة كاظم جهاد –
بيروت – دار بن رشد 1983، ص44)، (عبد الله أبو هيف – الأدب العربي وتحديات
الحداثة). إن الحداثة "بعد مفهومي"، وليس "بعدا زمنيا"، لأن
وعي الكتابة لأسلوبها ووظيفتها في التاريخ، اتفاقا مع أكثر التعبيرات الحضارية،
واستجابة لتحديات الحداثة، و"بقدر ما يظل الوعي المحدث محافظا على نقاء رفضة
الحلول الجاهزة، مؤمنا أن النسبية صفة محايثة في صنعه، وأن البحث والسؤال هما
المحرك الأساسي لهذا الصنع، يل هذا الوعي محافظا على حداثته، مؤمنا بسرها الذي لا
ينطوي على انتصار نهائي، بل على صراع دائم للانتصار على الانتصار نفسه"
(عصفور جابر: معنى الحداثة في الشعر المعاصر – في مجلة "فصول" القاهرة –
المجلد 4 – العدد: '، يوليو – اغسطس – سبتمبر – 1984 – ص54)، إن حركة النقد الأدبي
العربي الحديث محكومة بالسيرورة الثقافية على وجه العموم، وبسيرورة إبداعه على وجه
الخصوص، فالنقد الأدبي جزء لا يتجزأ من نشاط الفكر العام أو الصنع الثقافي في مجتمعه،
مثلما هو إبداع غير ناجز، أو غير معترف به، كما يشعر بعض النقاد، وهذا ما دعا علي
شلش إلى صياغة مواربة: "النقد إبداع، هو الوجه الآخر للإبداع أو هو إبداع
مكمل، ومثل هذه الحيرة، ومثل هذه المعاناة، لابد أن تؤدي إلى الحماسة المعلنة،
ولكن النقد يعيش، كما أثبتت تجربة الحياة، حتى في نفوس أولئك الذين يطلقون بحقه
الأحكام العرفية وإذا كان بعض النقاد قد التفت إلى تجليات المنهج والمصطلح والموقف
ومكانتها في تجذير النقد العربي ضمن تقاليده وأصالته الثقافية وتمكينه من نظرية
نقدية عربية، فإن قوانين أخرى لا تزال أحوج ما تكون إلى تقدير فعاليتها، أو
بالأحرى اندغامها في السيرورة الأدبية والثقافية بعامة، أعني بها مشكلات القراءة
والجمهور والعملية الإبداعية في النقد ومشكلات النقد في المنظومة الفكرية
والإيديولوجية والعلوم الإنسانية، مما يفضي إلى الموقف من الغرب والتراث. أما الانشغال
بالنظرية النقدية والتأصيل النقدي فقد ركز على ملامح الشغل النقدي في بعض مفاصله
الأكثر تساؤلا: الانطلاق من سؤال الغرب، والتوقف عند سؤال الغرب، طلبا لهوية عربية
للنقد الأدبي: "إضفاء الخصوصيات القومية على النقد العربي" ونهوض النقد
العربي من تاريخه وتجربته وتطلعاته المشتركة بعد ذلك، مما يستدعي معالجة أعمق
وأوسع للغة النقد ورسالته وأهمية عنصر الاتصال فيه، ثم تمحيص المناهج النقدية
الأوروبية وصلاحيتها لدراسة الأجناس الأدبية العربية، والوعي التأسيسي بالتراث
النقدي العربي، وفاعلية استمراره وحواره اليقظ مع الإبداع العربي المعاصر،
وقابلياته في التطبيق والتأثير وتشكل النظرية النقدية اليوم. د. حسام الخطيب
(فلسطين) ج1: فقضية النقد العربي الحديث مخزنة، إنه يحاول أن يولد فلا يستطيع،
والمسألة ليست مسألة أزمة كما يصنفها كتاب الزوايا الثقافية في الجرائد، المسألة
ليست مسألة ولادة، عدة محاولات سابقة، جرت من أجل إنجاز عملية الولادة، وبذلت جهود
طيبة وخيرة ومخلصة ومحقة، منذ أيام سليمان البستاني وروحي الخالدي وقسطاكي الحمصي،
إلى أيام العقاد والمازني وطه حسين، إلى أيام جبرا ابرهيم جبرا وإحسان عباس وعبد
القادر القط وسيل النقاد الأكاديميين من أبناء جيلهم، وأخيرا إلى نقاد الواقعية
الاشتراكية والحداثية والبنيوية وإلى تأسيسات حسين مروة وأدونيس وعز الدين اسماعيل
وغيرهم. حسام الخطيب: ولست لأنفي إطلاقا أن هناك تقدما يحصل (ولكن ليس بالقدر
الكافي) وأن جذوة النقد تجد دائما لها وقود من طلاب الاستشهاد الأدبي، ولكن
الولادة بالمعنى المطمئن لما تحصل حتى الآن ولا يعني ذلك أنها غير قريبة الحصول.
فلا يخامرني شك من أن ولادة النقد العربي الحديث غير بعيدة، ولكن تبقى مشكلة هي أن
كل أديب، وليس كل اتجاه فهذه مشروعة، يريد للنقد أن يولد على شاكلته وهواه، وإذا لم
يكن كذلك فهو ليس نقدا، ياليتهم يقولون نقد ضعيف أو متحيز أو غير موثوق، إنه ليس
نقدا وكفى الله المؤمنين القتال. حسام الخطيب ج2: فالنقد معاناة، وملابسة غير
مأمونة العواقب، ولهاته وراء كل جديد، ووجدان وظمأ للإنصاف النقدية بين الإخلاص
لقضية النث والالتباس بمسألة صاحبه أو كاتبه، النقد إحاطة وثقافة ومتابعة، والنقد
حساسية وشفافية وحسن تناول. حسام الخطيب: إن كل نقد هو نقد مؤقت إلى أن يظهر نقد
جديد، ولكل جيل طريقته في التعامل مع الآثار الأدبية، وكل مخترع علمي كبير أو
ابتكار فلسفي أو تغير في الزي الاجتماعي يؤدي إلى أن يصبح كل نقد راهن (بائخا)
ومسلوب الطزاجة وهكذا على الناقد الذي يريد لنقده أن يعيش أن يكون قطعة بسبعة
أرواح وفي كل روح سبعة أخرى، وهكذا دواليك. حسام الخطيب: وكل النقد يعيش، كما
أثبتت تجربة الحياة، حتى في نفوس أولئك الذين يطلقون بحقه الأحكام العرفية. علي شلش
(مصر) ج1: لا زال النقد الأدبي في الوطن العربي اليوم متخذا الطابع القطري، وهذا
لا يكفي على الإطلاق، ذلك أن وسائل الاتصال الحديثة: الكتب والصحافة الأدبية
والاتصال الشخصي قد ازدادت، بل هي في ازدياد مستمر ومعنى هذا أن يواكب النقد الأدب
تطورات الأدب العربي على مستوى القومي، ولا زال النقد الأدبي في الوطن العربي أيضا
مهموما بالتطبيق في الدرجة الأولى، على حين أننا نستطيع كنقاد أن نحدث رعشة على
الأقل في كيان النظرية النقدية بما عندنا من خبرة نظرية سابقة ومن خبرة حديثة
وليدة الاحتكاك بخبرات الغير وتطبيقات العصر على المستويات الإنسانية والقومية
والقطرية، علي شلش ج2: النقد في رأيي هو الوجه الآخر للإبداع، أو هو إبداع مكمل،
لأن الإبداع عندي هو الأدب على الوجه الأول للعملة والنقد على الوجه الآخر لها،
ومن ثمة لا يمكن التقليل من شأن النقد أو الناقد. علي شلش: عندي إنني أعمل على
ثلاثة محاور: - المحور الأول: هو استجابتي التلقائية للنص بعد طرح المؤثرات
الخارجية.
- المحور
الثاني: هو اعتقادي بأن النص الأدبي وليد خبرة إنسانية خاصة قبل – أن تكون أو-
أتتجه للعامة أو الكافة، وهي خبرة يكون المبدع قد عاشها أو عايشها من خلال إحساسه
الخاص الفرد وصهرها داخل قدرته أو موهبته التخيلية وقدمها في رؤية إنسانية وتناول
فني.
- المحور
الثالث: هو اعتقادي بأن النص الأبي لابد أن يحمل في طياته عنصر الاتصال بالغير أو
ما قد نسميه بالرسالة، مهما تنصل المبدع نفسه من شبهة التكليف المحاور الثلاثة تتم
العملية النقدية عندي.
د.
محمود طرشونة (تونس) ج1: هناك من يتحدث عن أزمة في النقد الأدبي العربي في الوقت
الحاضر، وإذا كان المقصود من كلمة (أزمة) غياب منهج عربي متميز وواضح المعالم
والمقومات، فهذا صحيح، أما إذا كان القصد منها قلة الممارسات النقدية، فهذا يحتاج
إلى نقاش لأن التراكمات النقدية اليوم بلغت حدا لم تبلغه في أي وقت سابق. محمد
طرشونة ج2: أعتبر أن التقيد بمنهج واحد وإسقاطه على جميع النصوص مهما كانت طبيعتها
يؤدي إلى التحريف والتعسف وينتج نقدا يهضم حق النصوص التي ينقدها. لأن العديد من
النقاد انبهروا ببعض المناهج الشكلية وأساؤوا فهمها فأساؤوا تطبيقها وأنتجوا قراءة
مبتورة لا تتعامل مع النص ولا تفجر جميع طاقاته، وقد حاولت ألا أقع في هذا الفخ
المنهجي الخطير فاستنطقت النصوص التي حللتها اعتمادا على جميع شبكاتها الدلالية
وأبعادها الفنية والاجتماعية، والعلاقات التي تربطها بنصوص أخرى معاصرة أو سابقة
لها. ثمة ضربان آخران متعارضان من النقد لا يسهمان في تطوير الظاهرة النقدية، ولا
يسيران بها في الاتجاه الصحيح وإن كان كلاهما يصنع لنفسه بشكل أو بآخر جدولا صغيرا
أو رافدا له وضعه الخاص ضمن هذه الظاهرة أو لهما النقد الجامعي وثانيهما النقد
الصحفي. وراء هذه الضروب من النقد يوجد لون آخر نادر ما زال يستوي على سوقه، لا
يركن إلى الجهل أو الشتم، ولا يعبأ بتصلب المؤسسات التعليمية وعنادها، ولا تهمه أو
تعيقه ثرثرات (الشلل) الأدبية، يقوم به أساتذة جامعيون خارج نطاق الجامعة أو
مختصون أدباء مثقفون هو ما نطلق عليه اسم النقد العلمي الجاد أو البناء، لذا يتميز
النقد بالخصائص التالية:
1. هو
نقد منوع يتناول جميع الأجناس الأدبية والأنواع الفنية، وإذا كان نقد الشعر اللغوي
منه بالذات هو الغالب من قبل فإن النقد اليوم يشمل كل الأنواع على اختلافها وبدرجة
واحدة من الأهمية.
2. هو
نقد مثقف لا يعلن عن ثقافته إعلان الدعاية بقدر ما يوظفها بدءا من القراءة الواعية
وانتهاء بالتحليل العميق توظيفا يضيء النص ويجعل قارئه أكثر وعيا وفهما وتذوقا.
3. هو
نقد ممنهج لا يعرف ضربات الريشة في الهواء الطلق بل يدرك مواقع خطاه على الطريق،
ومهما تعددت مناهجه، وهذا في ذاته دليل صحة وعافية، فإنها لا تخدم في النهاية إلا
ظاهرته تعمقها.
4. وهو
نقد يتراوح بين الموسوعية الشمولية والتخصصية المعمقة.
لئن كانت الصفة الأولى من خصائص النقاد القدامى، حيث الإحاطة صفة العصر فإن
الصفة الثانية من خصائص النقاد المحدثين حيث العمق لا يقل قوة عن الشمول، وقد بدأ
هذا النقد يتلامح عبر تاريخه الحديث هنا وهناك إلا أنه اليوم يعد – رغم قدرته –
نقدا متطورا عما سبقه، أثرى منه وأغنى وإن كان يفتقد في كثير من أموره إلى الدربة
والمرانة شأنه في ذلك شأن الفن الذي يلازمه، وأحسب أن هذا النقد في العديد من
نصوصه المدونة يتحول ليكون في ذاته أدبا أو في قيمة الأدب، أليس كلاهما خلقا
وإبداعا ورؤية وبناء، يقومان على التحليل والتركيب مهما كانت سمة الخطوة التي
يبدئان بها عملهما؟، ومع ذلك فتمة ظاهرة في هذا النقد الجاد نلفت النظر إليه في
سنواته الأخيرة تلك أنه تخلى إلى بعدما عن الوقوف عند العصر وحياة المؤلف وشخصيته
واعترافاته كمداخل تصل به إلى النص، وبدأ يركز وبشكل واضح على النصوص الأدبية
يدرسها ويفسرها ويحللها لأنها هي التي تعنيه، إننا لنأمل من هذا النقد في المستقبل
أن يخطو ثلاث خطوات ضرورية، الأولى ألا يقتصر الجهد فيه على الفرد بل يتحول إلى
الفريق، فعن طريق هذا الفريق وروحه يمكن أن يكون النقد مشروعا تعاونيا يبحث عن
غاية مشتركة، والثانية تتصل بالأولى وهي أن يعمل النقد على تلمس ملامح عامة للنصوص
فلا يكتفي بتناول الأعمال بصفتها الفردية بل بصفتها طريقا يؤدي إلى تكوين نظرية،
والخطوة الثالثة أن يجعل النقد حدوده أكثر وضوحا وأعظم تمايزا، وهو هدف أهم من هذه
صورة سريعة لواقع النقد الأدبي في العالم العربي. لأن مشكلة المصطلح من أبرز
المشكلات التي يكابدها الباحثون والنقاد في عالمنا العربي على مختلف علومهم
ومناهجهم ومباحثهم، وربما يعود سوء الفهم أو عدم التواصل فيما بينهم إلى هذه
المشكلة بالذات، فما من مصطلح يكاد يكون موحدا أو متفقا على دلالته، يستوي في ذلك
المصطلح العام الذي فقد دلالته من كثرة دورانه على الألسنة أو الأقلام، والمصطلح
الخاص الذي فقد دلالته على صاحبه بحيث لا يعرف فحواه سواه. أما المنهج نقطة البدء
في كل تفكير سليم، وهو بالضرورة من اختيار الناقد أو الدارس، ولا علاقة له
بالوقائع الطبيعية التي لا اختيار لنا فيه، فكل ناقد أو باحث أو منظر يختار منهجه
أو نقطة البداية تبعا لموقفه وتصوره ورؤيته وتكون أحكامه التي ينتهي إليها صوابا
أو خطأ وفق ما يتخذه من مبدأ أو منظومة أو منهج. نعيم اليافي: لأن الفن أي فن
بوصفه نشاطا أو فاعلية لا يمكن تثبيته أو حصره في قوانين إعلاءية أو تقاليد ثابتة
تخرج عن حدود الزمان والمكان، هو كالإنسان خالقه ومبدعه يتطور بتطوره من عصر إلى
عصر ومن جيل إلى جيل وحتى لدى الشاعر عينه ومن طور إلى طور، وما دام الفن كذلك فإن
النقد وصيفه وربيبه لابد أن يتطور هو الآخر بتطوره بتطور بمقاييسه ومعاييره ووجهات
نظره، ومن هنا كنت أقول: يجب أن نأخذ من كل تيار حبره الذي نكتب به عنه، فلا نعود
نقيس قصيدة الشعر الحر بمواصفات القصيدة التقليدية، ولا القصة الفنية بأصول
الحكاية ولا المسرحية الحديثة بمفاهيم خيال الظل. عبد الرحمان بن زيدان ج1: إن
الحديث عن واقع النقد العربي يتطلب – أولا – التعرف على مكونات هذا الواقع،
وتحليله وإعادة بناء فهم تراكماته، حتى يتأتى لنا القبض على المواقع الساخنة فيه،
والمنطلقات والخلفيات التي تحدد سيرورته، وهذه عملية لا يمكن أن تتم بمعزل عن
الموقع الحضاري الذي يحتله الإبداع العربي في حواره مع ذاته، وفي حواره مع الآخر،
سواء تم ذلك بالتأمل وطرح أسئلة، أو تم عن طريق التفاعل الصدامي الذي يريد أن يثبت
الذات ودورها وخطابها في المقول الأدبي، والواقع العياني، كما يرى عبد الرحمان بن
زيدان: الآن نجد أن النقد العربي أصبح حاضرا بهويته المتجددة حسب اللحظة التاريخية
وما تمليه من تغيير، أصبح يمتلك القدرة على استنطاق النص، والبحث عن المسكوت عنه،
والمعبر عنه بالإيحاء والرمز والصورة عوض المباشرة والانفعالية الزائدة، فاليوم
نقول أن الغرب قد طور جهازه المعرفي، وأدواته الإجرائية ورؤيته للإنسان والعالم،
لكن أين موقع النقد العربي من هذا المنتج؟ هل هناك علاقة استهلاك وتبعية؟ أم هنا
تجاوز وتحدي هذا المستورد لإضفاء الخصوصيات القومية على النقد العربي؟ هذه الأسئلة
تحيلنا على التأكيد على أن الإبداع العربي حاضر في الشعر والقصة والمسرحية حاضر
بانغراسه في التربة القومية لمعانقته، ما هو إنساني، موجود في هذا الوجود بوعيه
ومسؤوليته ومعاناته، إنه الجسد المتحرك الذي يخلق ارتباطه بالواقع، بالماضي من أجل
تفجير الحاضر وبناء المستقبل بطرح الممكن، وطبعا فإن النقد هو نفسه حاضر وهو يقارب
النص، يحلل عناصره، يبحث عن وظائفها في فضاء النص، وهذا ما أعطانا مجموعة من
النقاد الذين أثروا الحركة النقدية بكتاباتهم وتجربتهم لأدوات نقدية لا تنتصل من
الموروث ولا تقبل الجاهز المستورد، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، محي الدين
صبحي، كمال أبو ديب، عدنان بن ذريل، أدونيس، خالدة سعيد، يمنى العيد، جابر عصفور،
وعبد السلام المسدي، ومحمد برادة وغير هؤلاء الذين بلوروا مناهج نقدية تراعي
خصوصيات النص والظرف الذي قيل فيه، ومن هنا وجدنا من يدعو إلى الأسلوبية،
والشعرية، والبنيوية، والبنيوية التكوينية، والسيميولوجيا والشكلانية، إنها
المناهج التي تتجاوز وتحاور النص، تعيد خلقه وبناءه، لشد الأدب العربي الحديث إلى
زمانه وصراعه وانفتاحه على المستقبل وذلك عبر طرح السؤال النقدي لإنتاج الخطاب
النقدي، عبد الرحمان بن زيدان ج2: لقد ظلت بعض الكتابات النقدية التي تتناول العمل
المسرحي والفرجة حبيسة التعامل مع المضامين فقط دون الانتباه إلى زخم الفرجة،
والعناصر المتحكمة في خلقها وإبداعها وحركيتها، فغلبت النظرة التقويمية الإيديولوجية
للعمل من خلال المنفعة الآتية على التي تتطلب التعبير الآني عن المرحلة، ومن خلال
الهروب – المتعمد – غلبت على اقتحام كون النص وما يحيل به من دلالات إنسانية تلغي
الحدود وتقفز فوق العراقيل. لقد انطلقت بعض التراكمات في هذا المجال، وقمت بنقدها
فوصلت إلى أن النقد المسرحي كان ينظر إلى الأدبي بما هو سياسي فقط، في حين أن
المسرح كنص أدبي ودراما وإخراج يحتوي على السياسة دون أن يجهز بذلك لأنه، يكتب
المقالة السياسية التحريضية أو الخطبة التعليمية، بل يعمل بالإيحاء والرمز والأدبي
لصنع خطابة، وطبعا فإن هذ المرحلة قد تبلورت في كتابات سعد الله ونوس التنظيرية
ودراسات علي عقلة عرسان ورياض ورياض عصمت وفرحان بلبل وعبد الله أب هيف، حيث تم
الجمع ما بين طبيعة الأدب ووظيفته، ما بين شكله وهيأته ومضمونه، إنه العمل الذي
يصب في نهر الإبداع العربي والذي ساهم فيه كل من علي الراعي ويوسف ادريس وفرقة
الحكواتي وجماعة المسرح الاحتفالي بالمغرب، وعز الدين المدني بتونس، إذن من هذه
الرؤيا حاولت الاقتراب أكثر من طبيعة النقد العربي وتوجهاته، من وظيفته وهو يشتغل
على النص المسرحي، يفتته ويعمل على إعادة تركيب معناه ومضامينه لتجميع التجارب
وتمثلها وهي تعمل على تأسيس قواعد إجرائية وأدوات لقراءة المسرح العربي كظاهرة
حضارية تمارس حضورها وتأثيرها للبحث عن الأفضل في المؤسسة الأدبية نفسها وفي
الواقع الاجتماعي كذلك، من هنا انطلقت من موقعة التجربة النقدية التي قرأت الظاهرة
المسرحية بالمغرب فوجدت أنها تتطلب المراجعة، فقمت بعملية نقد النقد، فوجدت أن كل
التراكمات في هذا المجال لم تخرج عن التاريخ والتأرخة للظواهر المسرحية المغربية،
حيث أن الكتابات الأولى في هذا المجال – كانت تنطلق من الدفاع عن الذات وملء
الفراغ الذي أحدثه غياب المسرح بمفهومه العربي – عن التربة المغربية، فكانت كتابات
الطيب العلج وعبد الله شقرون إرهاص أوليا لهذا الدفاع، أما ما كتبه حسن المنيعي
ومحمد أديب السلاوي فإنه كان رصدا للنشاط المسرحي بالمغرب أثناء الحماية الفرنسية
وبعدها، لكني حاولت أن أخالف هذا حيث انطلقت من النصوص ذاتها فحاولت قراءتها ووضعها
في صورتها التاريخية دون إهمال جمالية الأداء، وفنية التقديم، وهذا يعتبر في حد
ذاته إضافة نوعية كانت تمليها الحياة الاجتماعية وكانت تفرضه على المبدع من تحول
وتغيير في أدواته، كما يرى عبد الرحمان بن زيدان: إنه لا يمكن فصل إشكالية الإبداع
المسرحي عن الإبداع النقدي، لأن الأول يطرح أسئلته على نفسه وعلى الآخرين من خلال
رؤية الكاتب للعالم والمتضمنة في جوانب الإبداع، أما النقد فهو الآخر بطرح أسئلته،
وليقوم بالكتابة فوق الكتابة، بموقع الإبداع الأول كمستويات تضم لغتين طبيعية
واصطناعية، وهما في ديالكتيك الدال بالمدلول، والواقعي بالمتخيل، لإنتاج خطاب غير
بريء، لأنه ينتمي إلى موقع، وإلى مؤسسة تدافع عن مصالح بهدف التأثير على المتلقي
المتفرج، أو إلى قاعدة جماهيرية تعبر عنها المسرحية، عن طموحها لنقل وعيها
التاريخي إلى المتفرج، لأن ضرورة تجديد قراءة النصوص ونقدها يتطلب رؤية جديدة
وأدوات مغايرة، لأن ما تحبل به النصوص المسرحية العربية يتطلب ذلك، ومن هنا وجدتني
أجابه مجموعة من الأسئلة التي يطرحها على النص المسرحي بالمغرب سواء تعلق ذلك
بعلاقته مع التراث العربي، أو الأوروبي أو العالمي، وهي علاقة تستوجب الاقتراب
منها للتعرف على التيارات الأدبية والفكرية والإيديولوجية الرابطة في عمق ما تعبر
عنه وما تحمله، لقد انتقدت أولا التيار الذي كان يروج لمسرح اللامعقول والعبث وهو
غير متبنى عن وعي أو قناعة، ولكن لتجريب ما عند الغرب فقط، فكانت النتيجة هو تخلي
هذا التيار عن المسرح، لأنه أعلن عن إفلاس أدواته وخطابه في واقع يحتم على الأديب
نوعا من الواقعية العميقة البعيدة عن الإسفاف والمغالاة، كما انتقدت دور بعض
المؤسسات في تدجين المسرح وجعله تابعا لها لخدمتها والدفاع عن طبقتها، سمر روحي
الفيصل ج1: يواجه النقد الأدبي العربي في هذه الأيام، مجموعة من الأسئلة الصعبة،
أبرزها الموقف من المناهج النقدية الأوروبية، وخاصة صلاحيتها لدراسة الأجناس
الأدبية العربية، وتحديد علاقة هذه الأجناس بالمجتمع العربي وبالتراث وبالمبدعات
الأوروبية، حيث تضج الطريق إلى نظرية عربية للنقد الأدبي بالممارسات النقدية التي
تتعامل مع المناهج الأوروبية وتسعى إلى الاستفادة منها، وعلى الرغم من أن هذه
الممارسات ستواجه في النهاية مشكلة المرجع الاجتماعي التي أشرنا إليها، إلا أن
المرء يلاحظ انتقال النقد الأدبي العربي منذ السبعينات إلى التماسك المنهجي
والمرونة في توظيف المناهج الأوروبية، يوسف سامي اليوسف ج1: إن ما أنجز من جهود
نقدية أدبية في القرن العشرين على امتداد العالم العربي ليس بالشيء اليسير، ولو
أنه ليس بالشيء الكافي أو الشديد التطور، وللحق أن الأزمة يمكن أن تكون أزمة النقد
الأدبي، بل أزمة الثقافة العربية برمتها، فالثقافة العربية الحديثة فقيرة إلى حد
ما بالعناصر الأساسية للثقافة، فالعلوم النظرية لم تنضج بعد، وربما لم تبدأ بعد:
علم الاجتماع، علم النفس، نظرية التاريخ، فقه اللغة... الخ، والفنون (الرسم،
الموسيقى...الخ)، لم تنضج، وليس ثمة من مؤشرات تؤشر إلى أنها سوف تنضج على المبدأ
المنظور، وحتى الأدب العربي الحديث ما انفك وليدا يحبو، فالرواية والمسرح لم
تتقدما بعد الشأن والمأمول، وعندي أن النقد الأدبي تابع للأدب نفسه، وهذا يعني أن
تقدم النقد من نتاج تقدم الأدب بالضرورة، يوسف سامي اليوسف: على أية حال، لم نستطع
أن نتعلم من الغرب إلا القليل، فالنقد الأدبي في الغرب مدارس وتيارات، أما عندنا
فكل ناقد تيار قائم بذاته، ويبدو لي أننا موغلون في الفردية فكل امرئ منا شأنه
الخاص، وما فينا من يقبل – إلا لما أو على ندرة – أن يتعلم ممن سبقه أو تقدم عليه
في الزمان، وحين يتعلم فرد من فرد آخر فإنه يحاول أن ينكر ذلك أو أن يتحفظ عليه،
بل إن عندنا من يسرق أفكارك وإذا ما أبديت أيما احتجاج شتمت، وإذا ما استمر هذا
الحال من التفاصل على ما هو عليه فإن تشكل المدارس النقدية سوف يكون في
المستحيلات، ولئن راجع المرء تاريخ أية ثقافة من الثقافات فإنه سيقتنع بما فحواه
أن الثقافة لا تغتني إلا عبر المدارس والتيارات، ويقول غالب هلسا (الأردن): ج1:
كنت – في السابق – أقرأ معظم ما يكتبه طه حسين، حسين مروة، محمد ابراهيم دكروب،
رجاء النقاش، لهذا مع أخذ المبررات السابقة بعين الاعتبار، بعد من ذكرت وأجيالهم
من النادر أن أجد نقدا ذا قيمة، فالنقد يتوزع بين ما تنشره الصحف والمجلات والنقد
الأكاديمي، محمد منقذ الهاشمي ج1: نحن نطلق مصطلح "النقد الأدبي" عادة
على عدد من الفعاليات الثقافية تختلف في غاياتها وأسسها ومنطلقاتها وطرق تناولها
لموضوعاتها وخلفياتها الثقافية ومستوياتها والقراء الذين تخاطبهم، محمد منقذ
الهاشمي: لقد وفق النقد الأدبي العربي الحديث إلى خلق بعض "الالتماعات"
التي نجدها في هذا الكتاب أو تلك المجلة، وإلى شيء من التجديد في مناهجه وأدواته
ومصطلحاته وإلى أن يفرض احترامه على القراء والجامعات ومؤسسات النشر، ولكن النقاد
أخفقوا إلى الآن في الاتفاق على المسلمات التي يجب أن توحد بينهم، وأخفقوا في أن
يكون لهم صوت جماعي، وأخفقوا في خلق العقلية النقدية الأولية التي تسهل على القراء
والناشرين التمييز بين الناقد والمتطفل، وكان إخفاقهم كبيرا في أن يحلوا لغة
الحوار بينهم بدلا من "الرفض الكلي والقبول الكلي" لأن الثقافة السائدة
هي ثقافة "الأبيض والأسود" والفرض بالقوة والتهديد، وكان أكثرهم عاجزا
عن أن ينجو من أسرها، فالسلفي يريد كل النقاد أن يكونوا سلفيين، والتوفيق يريد كل
النقاد أن يكونوا توفيقيين، والمجدد يريد أن يفرض التجديد على كل النقاد، محمد
منقذ الهاشمي: إلا أن الأخطار التي تهدد النقد العربي الآن تتمثل في عدد من النقاط
أهمها أن بعض النقاد ينجرفون وراء بعض التيارات الأدبية والأمريكية دون أن يكون ما
تبنوه ثمرة جهودهم المتواصلة ودراساتهم المتعددة وبحثهم الطويل وقراءاتهم المستمرة
وبصائرهم الخاصة بل نتيجة الخضوع المفاجئ لما يرونه الآن زيا حداثيا جدا في هذا
البلد أو ذلك من بلدان أوروبا، وبالإضافة إلى أنهم سيضطرون في أية ساعة مفاجئة
لاحقة أن يلفظوا كل ما كتبوه بناء على زي آخر قد يظهر في أي وقت فإنهم سيخفقون
حتما في تطبيق ما أخذوه على الأدب العربي لأنهم أخذوه مقطوعا عن قرائنه الثقافية
والمفهومات الفلسفية والعلمية التي نشأ منها وسوف يتعسفون في استخدامه، ويقعون في
التناقض نتيجة التناقض الذي لا مفر منه بين ما بقي لديهم من أفكار فلسفية وإنسانية
وعلمية وهذا المنهج النقدي الجديد الذي اقتحمهم اقتحاما مباغتا، محمد منقذ
الهاشمي: والناقد بهذا المعنى موجود ولكنه نادر، وكل الظروف تسهم في أن يكون عدد
النقاد قليلا، ولن نتوقع أن يزداد عدد النقاد ما لم يحدث تغيير جذري في بنيتنا
الثقافية العامة.
- التقاليد
والتجديد في المسرح العربي المعاصر:
رغم أنا أنشد أصالة في عملي المسرحي، غير أنني أحس دائما، أن التراث المسرحي العالمي ملك لنا، ونحن عنصر مكمل له، ولا يمكن أن نكون شخصيتنا المسرحية القديمة في الفراغ، وإنما في محاولة الوصول إلى تبادل التأثير والتأثير مع المسرح في العالم، ألفريد فرج ج4: فالمسرح العالمي لم ينتبه بعد إلى جهود الفنانين العرب ليتأملها، وهذا لدواعي حضارية كثيرة، ولكن أعتقد أن الفنانين الأوروبيين قد التفتوا التفاتة صغيرة إلى الفلكلور العربي ولكنهم إلى الآن يجهلون كل شيء عن إبداع الفنانين العرب في مجال المسرح، الطيب العلج ج3: المسرح الأجنبي اعتبارا لما أسلفت في الجواب عن سؤالكم الأول، كان مدرسة لنا في البدء، ولكن يجب ألا نل عبيد هذه المدرسة، ونحن بصدد البحث عن هوية، إن سنة الخلق في كل الفنون، تقوم على الأخذ والعطاء، لقد أخذنا بما فيه الكفاية، وأعتقد أنه آن لنا أن نعطي للمسرح العالمي نماذج ذات سمات مميزة وطابع خاص، وليد إخلاصي ج3: من القول المكرور أن نتحدث عن تأثير المسرح الغربي في حركة المسرح العربي، إذ أن عدوى التفاعل تستشري لتأخذ أبعادا كثيرة، فالدراما المكتوبة ذات جذور غربية، كما أن العمل المسرحي المجسد يرتبط بالتكنيك الغربي، هناك محاولان اليوم لخلق الشخصية العربية، وهذه المحاولات إنما هي تعبير عن الصحو العربي الحديث، ليس من العيب أن نأخذ عن الغرب مسرحا، كما أن الشرق (اليابان والصين وغيرهما) يمكن أن يمدنا بالتجربة، إنما العيب ألا نجرب، ونبحث عن التفرد في أدائنا، ودليل ذلك أن تراثنا الشعبي منفرد، فلم لا يكون المسرح؟ وأعتقد أن التجريب المستمر سيقود إلى هذا التفرد، هاني صنوبر ج3: لاشك أن بعض المدارس في البلاد العربية قد نهجت نهج المسرح الأوروبي في تقاليدها المسرحية، وفي إنتاجها للمسرحيات، إما عن طريق الاقتباس أو السرقة الفنية أو التغريب، إلا أنه قد ظهر في الدول العربية الأخرى التي بدأت بالفعل في تقديم أعمالها من كتابها المحليين مثل سورية ولبنان والكويت (من فترة قريبة جدا، وهي نقطة تحول في تاريخ المسرح الكويتي وأذكر بالتحديد مسرح الخليج الذي قدم ثلاثة أعمال حتى الآن هي "شياطين ليلة الجمعة" و"النمرة الثانية بحمدون المحطة" والعمل الثالث هو "علي جناح التبريزي"، هاني صنوبر ج4: بالتأكيد، وبالفعل مؤسسات النشر الغربية بترجمة إنتاج كتابنا المسرحيين العرب وعلى رأسهم سعد الله ونوس والفريد فرج ومعين بسيسو، وقد نجحت هذه الأعمال عندما قدمت للجمهور الغربي بلهجته المحلية، وهذه أكبر دلالة على أن المسرح العربي قد قدم شيئا ولو أنه شيء قليل، وهذه مساهمة منه في توضيح نظر المسرح العربي أو إعطاء فكرة عن إيجاد الكاتب العربي العالمي، صقر الرشود ج1: إن المسرح العربي لم يأخذ شكلا متميزا بعد فهو يتأرجح بين التجارب الرديئة والتجارب العالية المستوى، أي لم يخلق شخصيته بعد، وقد يكون هذا بحكم الفترة القصيرة التي يعبر عنها تاريخ المسرح العربي، ونظرة الجمهور إلى المسرح لا تزال في الكثير من البلدان العربية على أنه شيء غير أساسي أو غير ضروري على مستوى الجمهور أو المسؤولين، صقر الرشود ج3: في المرحلة الحالية، يؤثر المسرح الأجنبي تأثيرا كبيرا، لأن المسرح العربي في طور التكوين نحو إيجاد الشخصية المتميزة، صقر الرشود ج4: طبعا، عندنا كتاب لا يقلون روعة عن الكتاب الغربيين المعاصرين ولدينا تراث مسرحي بحيث يمكن أن نقول: إننا أضفنا شيئا للتراث المسرحي العالمي، فرحان بلبل ج3: مسرحنا كتابة وتمثيلا وإخراجنا، متأثرا تأثرا كليا بالشكل المسرحي الأجنبي، لأننا تلقينا هذا الفن كله عن الغرب واتصالنا بالمسرح الأجنبي دائم ومستمر حتى أنه يظهر في تلقينا السريع والمباشر لكل الابتكارات الجديدة في المسرح الأجنبي، وهذا ليس أمرا سيئا بل إنه جيد، والأجود من ذلك أن ندرك أننا تلامذة المسرح العربي، وأن ندرك أيضا أن علينا أن نطبع هذا الفن الغريب بطابعنا الخاص، سواء في معالجة الموضوعات التي تهم المواطن العربي، أو في الابتعاد عن الأشكال المسرحية الغربية التي لا تلائم طبيعة جمهورنا، والملاحظ أن طابعنا بدأ يظهر على المسرح على شكل صغير لكنه لا يبث أن يقوى، من ذلك إدخال الفلكلور الشعبي، أو طبع التمثيل بطابع محلي، فرحان بلبل ج4: لا أظن ذلك، لأن المسرح العربي لن يضيف إلى تراث مسرحي عريق، إلا إذا بلغ درجة من القوة والنضج واستقلال الشخصية بحيث يستطيع التأثير بطابعه الخاص، على تراث يفتقر عنه، وما أظن أننا بحاجة إلى الاستعجال في هذه الإضافة، قد يقال أن بعض النصوص المسرحية العربية ترجمت إلى لغات أجنبية، وأن بعض الأعمال المسرحية عرضت على مسارح أجنبية، لكن هذا شيء والإضافة شيء آخر، لأن الإضافة تفترض التباين، وإذا كان مسرنا متباينا عن المسرح الأجنبي في موضوعاته فإنه ما يزال يأخذ عنه في البناء والمعالجة، جمال أبو حمدان ج3: أن خلو التراث العربي من فن المسرح أقصد هنا الفن المسرحي بعناصره المتكاملة واستحضار العرب للقالب المسرحي الغربي جعلهم يتجمدون ضمن هذا القالب، ويرتبط بالإجابة الثانية من حيث أنه لم تقدم حتى الآن تقاليد مسرحية أصيلة، تكون بديلا عن هذا الاستحضار للمسرح الغربي، لابد من لفت الانتباه هنا إلى بعض التجارب التي تمت في إطار الشكل لتطعيم المسرح العربي بظواهر فلكلورية عربية، نجد تجارب من هذا النوع في المغرب ومصر ولبنان وأقطار عدة، لكن هذا ما زال يقع في الشكل "البراني" للمسرح دون أن يحقق تحولا أساسيا نحو مسرح عربي، لقد ألبسنا التجربة التي استحضرناها من الغرب بعض الملابس العربية ولكننا لم نستطع حتى الآن أن نعطي ملامح وشكل مسرحي عربي داخل هذه الملابس، أعتقد أنه لا يمكن أن يؤثر المسرح العربي في التجربة المسرحية العالمية إلا من خلال أصالته، فهذه قضية تتحول في إطار البحث عن تجربة عربية تصل أولا إلى حد التكامل لتكون قادرة بالتالي على التأثير في المسرح العالمي، نحن لاحظنا من دراسة بعض الآداب العالمية أن الملاحم العربية كألف ليلة وليلة قد أثرت في القصة العالمية وكانت مصدرا إيحائيا لكثير من الأعمال الغربية، وألف ليلة وليلة كما أعتقد وغيرها من الأعمال الأدبية العربية تتضمن ظواهر مسرحية وأعتقد أن المسرح العربي لو استطاع أن يصل بهذه الظواهر إلى مسرح ذي مستوى فني جيد، فلابد بالعالي، أن يكون قادرا على إضافة شيء لتجربة المسرح العالمي المتنامية على امتداد التاريخ العالمي الثقافي، رشاد أبو شاور ج2: النقاش حول مسرح عربي، بدأ بين الأدباء، وكتاب المسرح، ومن ثم أثر في العاملين في المسرح، نحن نرى محاولات كثيرة الآن، تجري على منصة المسرح، وتحمل ملامح عربية، رأينا هذه المحاولة في (مقامات بديع الزمان الهمداني) التي قدمها الطيب الصديقي، في المهرجان الخامس للفنون المسرحية بدمشق، هذا العام رأينا (علي جناح التبريزي) التي قدمتها الكويت، والتي نجحت إلى حد في إضفاء الجو والطابع العربي، ولكن لي ملاحظة: إذا لم تكن المحاولات العربية، التأصيلية، نابعة من أسس متينة، فستتحول حتما إلى وسائل إبهار، وسيملها الجمهور حتما في رأيي، ليس المهم أن (نستحدث) شكلا عربيا مسرحيا، المهم أن تعبر عن آلام أمتنا، وقضايا جماهيريا هذا الوطن، أما الغناء، والرقص، فهذا لن يحقق مسرحا عربيا، إنه عرض أزياء عربية، ورقصات عربية، وليس مسرحا عربيا، رشاد أبو شاور ج4: لست أدري، ولكنني قرأت مرة، رأيا لناقد عالمي يقول – آسف نسيت اسم الناقد وأظنني قرأت هذا الكلام في مجلة المسرح المصرية – أن تطور المسرح في العالم، سوف يأتي من افريقيا وشعوب الشرق الأوسط والعالم الثالث، ربما يتحقق هذا لماذا؟ لأننا نحمل – رغم رداءة ظروفنا وواقعنا، مستقبل الحركة الثورية، التي من شروط تحققها أن تكون ثورية في كل شيء، وأهم هذه الأشياء: الأدب، والمسرح... والنقد، والمعرفة، والفكر، وهكذا لم تكن المناهج التي أنجبتها الحداثة الغربية في أي يوم بريئة من غاياتها السياسية، حسن يذهب الإيديولوجي المهيمن ليسوغ ثورته عن طريق وسائل التواصل، فلا يفعل إلا لخدمة طبقة سياسية تتصدر عرش العولمة، وعلى امتداد هذه الملحمة القطبية تتلقى امبريالية الصورة والصوت والثقافة بظلالها فوق عالم يترنح، وإنسان يواجه حالة من الضياع النقدي والانفلات الإبداعي، فالناقد لابد أن لا يتجاهل مسؤولية التأويل وثابته، لأنه الأرضية المتغيرة والحاملة لأسرار الوجود ومنبعا لمعرفة الأصل، والثابت والمتحول، لذا اقتضت ضرورة إبراز المسؤولية العلمية والمعرفية أن تذكر بالمبادئ التي تجري اليوم والأفكار والسياقات المرتبطة بالصور والرموز والاتجاهات الأدبية والفلسفية، ولعل هذا الفهم يعد بعدا فلسفيا انطولوجيا، حيث يرتبط ارتباطا وثيقا بما في المفسر ومستقبله، بمعنى أن الناقد محكوم بزمانيه المابعدية لأنه نقطة الانطلاق الجوهرية لعملية التأويل النقدي، بمعنى أن نحقق قدرا من ال
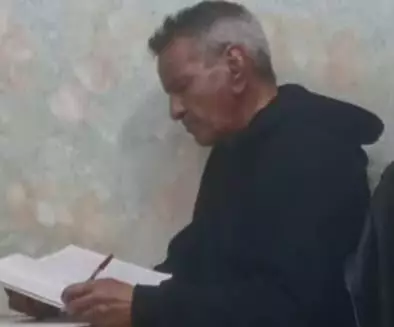
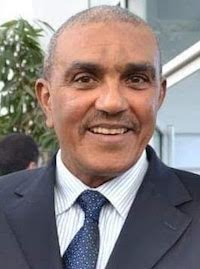



لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك