أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
منذ لحظة خروج آخر جندي فرنسي من
التراب المغربي دخلت البلاد مرحلة معقدة من أشكال الحكم والتجاذبات السياسية التي
تشابكت فيها طموحات الدولة الحديثة مع إرث ثقيل من السيطرة الاستعمارية وسيطرة
القواد على مناطق وجهات من المملكة، والتي تركت مؤسسات ضعيفة ومجتمعًا يبحث عن
ذاته وسط تحولات إقليمية ودولية كبرى.
وكانت السنوات الأولى للاستقلال
بمثابة معركة صامتة بين إرادة بناء دولة وطنية حقيقية وبين قوى متجذرة رأت في
الانتقال الديمقراطي تهديدًا مباشرًا لمصالحها الشخصية والأسرية.
وتزامن هذا المخاض مع إعادة تشكيل
المشهد السياسي على إيقاع صراع بين الأحزاب الوطنية، التي حملت عبء المقاومة
والنضال، وبين جهاز إداري وأمني موروث عن الاستعمار ظل يحتفظ بقبضته على مفاصل
القرار، متبني سياسة "الزميت" ومنذ ذلك الزمن بدأت تظهر علامات التأخر
في بناء مؤسسات قوية قادرة على تأمين مشاركة سياسية حقيقية، وهو ما انعكس على
طبيعة التجارب الانتخابية الأولى التي لم تكن دائمًا تعكس الإرادة الشعبية.
ومع اتساع الهوة بين الشارع والنخب
الحاكمة عبر الزمن تشكلت صورة قاتمة عن السياسة بوصفها مجالًا مغلقًا تديره قوى
غير خاضعة للرقابة الشعبية، لتتحول الانتخابات الشعبية تدريجيًا إلى طقوس شكلية
أكثر منها آليات شبه ديمقراطية حقيقية.
وبرزت منذ تلك المرحلة شهادات وشكاوى
وحتى مذكرات سياسية توثق لزمن التلاعب بالصناديق وصناعة الخرائط الحزبية بشكل
يُفضي إلى نتائج معدة سلفًا.
رئيس الحكزمة يهدد لا نستطيع أن ننتقد
إنتخابات 2026 نلمح ، "هذا جهدنا في زمن اللقوة"
ولم يمنع تطور الخطاب السياسي من
استمرار سياسة التحكم التي جعلت المشهد السياسي يعيش حالة من الركود المستمر، حيث
ظلت وزارة الداخلية لسنوات طويلة اللاعب الأساسي في كل استحقاق انتخابي، ما رسخ
الإحباط وولد شعورًا عامًا بأن التغيير الحقيقي مستحيل في ظل هذا النمط من التدبير،
وقد أدى ذلك إلى تآكل الثقة بين المواطن المغربي المدني والقروي والمؤسسات، وإلى
تحويل السياسة إلى مسرح بلا جمهور، "الشطيح والريديح شكون يرقص ويزغرت".
وزاد الأمر تعقيدًا دخول المغرب مرحلة
جديدة من الصراعات التي وُلدت من رحم ما سُمّي آنذاك بالتوازنات الكبرى، وهي
توازنات أرست شكلا من التعددية الحزبية العرجاء التي ملأت المشهد بأحزاب بلا مشروع
حقيقي، تفتقر إلى قوة اجتماعية حقيقية وتحولت إلى أدوات لخدمة الاستراتيجية
الرسمية بدل أن تكون أدوات لخدمة المجتمع، أحزاب "بهلوانات وكراكيز" كما
سماهم الراحل " الحسن الثاني" في قبة البرلمان، وهو ما عمق أزمة
المشاركة وقلص قدرة الفعل الجماهيري على التأثير.
وفي هذا السياق، كان الاقتصاد بدوره
يعيش أزمته الخاصة.
فبرغم الخطابات المتكررة حول التنمية
والتحديث، ظل النمو هشًا مرتبطًا بتقلبات المناخ والأسواق الأجنبية، بينما استمرت
الفوارق الاجتماعية بين الطبقات في الاتساع المتسارع المهول والخطير.
ولم يتمكن المغرب من بناء نموذج
اقتصادي قادر على خلق الثروة للفرد المواطن رغم الثرواة بشكل عادل، إذ بقيت
القطاعات الإنتاجية تحت رحمة الاحتكار والريع الذي استفادت منه شبكات نافذة تقضي
مصالحها الخاصة وعائلاتها فقط.
كما شكل غياب الإرادة الحقيقية
الصارمة للإصلاح إحدى العقد التاريخية التي عرقلة سلم التنمية والتطور رغم
الإمكانيات...
فكلما ظهرت بوادر انفتاح سياسي،
أعقبها تراجع سريع يعيد الأمور إلى نقطة البداية، وكأن البلاد محكومة بدورة مفرغة
تجعل الحركة السياسية تسير مثل موجات البحر، ترتفع بشدة ثم ترتد إلى الخلف بقوة
أكبر، ولن نذكر حزبا من باب التجرد الحقيقي، وهكذا بقي الانتقال الديمقراطي مجرد
وعد مؤجل لا يتحقق "تال غذا يوم القيامة".
وفي السبعينات والثمانينات، وهي مرحلة
توتر داخلي كبير، دخل المغرب منعرجًا صعبًا تميز بمحاكمات سياسية وتضييق على
الحريات وتراجع رهيب في الثقة، ما جعل بناء ديمقراطية حقيقية أمرًا مؤجلًا مرة
أخرى أو أجل غير مسمى، وقد تركت هذه المرحلة ندوبًا عميقة على الوعي الجمعي جعلت
الناس ينظرون للسياسة بريبة وخوف بدل أن ينظروا إليها باعتبارها وسيلة تغيير
وتطوير ينمي البلد أو يسوقه إلى منعطف الحرية الفردية أوالدمقراطية الحقيقية .
ومع بداية عهد جديد، ظهرت وعود
بإصلاحات عميقة، وبدأ الحديث عن الإنتقال نحو دولة المؤسسات، لكن الواقع بقي أكثر
تعقيدًا من الخطابات.
فظلت عدم ذكرالأسماء ليس غباء ولكن
أين الدمقراطية التي تحميني عن رأي نطقته، أو قلته.
فقد استمرت البُنى القديمة في التحكم
في آليات التأثير والاستفادة، بينما بقيت الأحزاب السياسية غير قادرة على التحرر
من منطق الوصاية غير المعلنة، ومعلنة في بعض الأوقات عن طريق المحاكمات وفيها
تلميحات، وبذلك بقي المسار الديمقراطي هشًا رغم بريق الوعود المتكرر.
ومع دخول القرن الجديد في سنة 2025،
أصبح المغرب أمام تحديات جديدة، في مقدمتها البطالة، التعليم، الصحة، والعدالة
القضائية، والعدالة الاجتماعية، وهي ملفات ظلت تراوح مكانها، مما عزز الإحساس بأن
السياسات العمومية لم تكن يومًا في مستوى انتظار المواطنين المغاربة الذين ينتظرون
تحول دمقراطي جامع، وكلما طال التأخير، زادت الهوة بين الدولة والمجتمع حتى أصبح
المشهد السياسي أقرب إلى مسرح معزول عن الواقع.
وفي ظل هذه التحولات، نشأت طبقة
سياسية جديدة تبدو حديثة المظهر لكنها في الواقع تكرس نفس الأساليب القديمة، فقد
اختلط المال بالسياسة، وتسللت شبكات المصالح لتحول الأحزاب إلى منصات انتخابية بلا
مشروع، مما حد من قدرة السياسة على لعب دورها الطبيعي كوسيلة لتنظيم المجتمع وبناء
المستقبل، وعانى المغرب كذلك من ضعف في استقلالية القضاء، وهو عامل أساسي في أي
تحول ديمقراطي، فغياب عدالة قوية ومستقلة يجعل كل إصلاح آخر بلا معنى، ويعزز
الإحساس بأن الدولة لا تزال تعمل بعقلية التحكم بدل عقلية المشاركة، ومع ذلك ظلت
الإصلاحات القضائية بطيئة وغير قادرة على قلب موازين القوة في مجموعة كبيرة من
الحقول.
ومن الأسباب التي عمقت هذا التأخر
أيضًا غياب ثقافة سياسية مواطنة لدى فئات واسعة، نتيجة عقود من التهميش والتبخيس
المتعمد للشأن العام، فقد تم تحويل السياسة إلى مجال منفر حتى يعزف الناس عنه،
وبهذا بقيت اللعبة السياسية حكرا على فئات قليلة لا تمثل المجتمع بكل مكوناته
وتطلعاته، كما لعبت وسائل الإعلام دورًا مزدوجًا، فهي من جهة كانت تسعى لفتح
فضاءات جديدة للنقاش، ومن جهة أخرى خضعت لسلطات التأثير التي جعلت جزءًا منها
يتحول إلى منصات لتبرير السياسات بدل مساءلتها، ما ساهم في إضعاف الوعي العام
وتعميق الفجوة بين الحقيقة والتمثلات.
وفي العقدين الأخيرين، بدأت
الاحتجاجات الاجتماعية تعود بقوة، تعبيرًا عن تراكم الغضب والخيبة، فقد خرج الشباب
إلى الشارع ليس فقط بسبب البطالة، وإنما أيضًا بسبب غياب شعورهم بأن لديهم مكانًا
في الحياة السياسية، والإجتماعية والإقتصادية...، وهو ما جعل الضغط الشعبي يتزايد
على الدولة لتغيير أسلوب التدبير والقطع مع الماضي.
ومع ذلك، ورغم جميع الإصلاحات
المعلنة، بقيت مسألة الانتقال الديمقراطي في المغرب أسيرة معادلة صعبة تجمع بين
الإرادة الجزئية للانفتاح وبين رغبة عميقة في الحفاظ على بنية التحكم، وقد جعل هذا
التردد عملية الإصلاح السياسي بطيئة وغير جذرية، وكأن البلاد تسير بخطوات قصيرة في
طريق طويل لا نهاية له، كما أن النمو الاقتصادي رغم تحسنه في بعض الفترات بقي غير
كافٍ لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، وحتى الدخل الفردي يتراجع يوما بعد يوم، فقد
ظل محصورًا في مشاريع ضخمة لا تنعكس بالضرورة على المعيش اليومي للناس، بينما بقيت
الفوارق الاجتماعية من أوسع الفوارق في المنطقة، وهو ما يجعل التنمية الاقتصادية
غير مكتملة وغير قادرة على خلق مجتمع متوازن.
وفي السنوات الأخيرة، خصوصًا مع تطور
وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح المواطن أكثر قدرة على كشف الحقائق، وأكثر وعيًا
بطبيعة الخلل، وأكثر جرأة في التعبير عن انتقاداته، وهذا التحول أربك المنظومة
السياسية التي كانت تعتمد لعقود على التحكم في المعلومة، لتجد نفسها اليوم أمام
رأي عام جديد يطالب بالوضوح والمحاسبة، ومع دخول البلاد سنة خمسة وعشرين وجد
المغرب نفسه أمام مفترق طرق حقيقي بين مواصلة إدارة السياسة بالأساليب القديمة
وبين الدخول في مرحلة جديدة تتأسس على مشاركة أوسع ومؤسسات أقوى ومسار انتخابي
شفاف، وهي خيارات تؤثر مباشرة في مستقبل البلاد واستقرارها وتقدمها.
ويبقى السؤال الجوهري هو مدى قدرة
المغرب على تجاوز هذا الإرث الثقيل من التحكم والتأجيل وبناء نموذج ديمقراطي
واقتصادي قادر على الاستجابة لطموحات شعبه، فالتجارب أثبتت أن التغيير الحقيقي لا
يأتي من الأوراق والدساتير بل من الإرادة الفعلية في القطع مع ممارسات الماضي،
وتطليقه طلاق الثلاث، فإن المغرب يقف اليوم أمام فرصة تاريخية لكسر دائرة الظلام
السياسي التي لازمته لعقود وبناء عهد جديد يقوم على الشفافية والعدالة والجرأة في
الإصلاح، ومن شأن هذه الخطوات أن تفتح باب الأمل لإخراج البلاد من تراكمات الغمام
إلى فضاء سياسي أكثر عدالة ووضوحًا إن توفرت الإرادة الحقيقية لذلك.
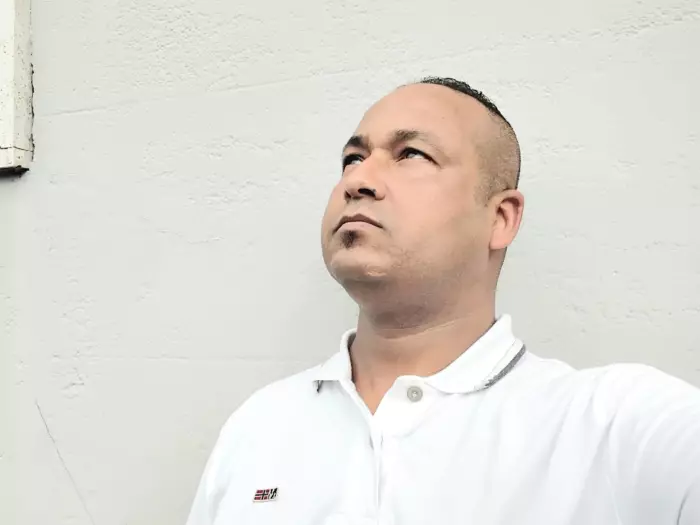




لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك