بقلم:أحمد زغلول
أدت أعمال العنف التي تواجه العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى بعض الاختزالات الشديدة. فالقضية، كما قيل لنا، هي الدين، بصفة عامة، والإسلام بصفة خاصة. فالدين يتسبب في الصراع وهو المسئول عن الحرب. وكما قال ستيفن واينبرج، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء وأحد كبار علماء الفيزياء النظرية الأمريكيين: “بالنسبة لأهل الخير فمن أجل أن تفعل أشياء سيئة، يتم استخدام الدين”
بالتأكيد يمكن أن يلعب الدين دورًا فاعلا في الصراع، وفي المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة، ولا تظهر الهوية الدينية لتكون في قلب العنف الذي ترتكبه جماعات مثل داعش وطالبان. لكن الرابط الذي يفصل بين الدين والحرب ضعيف جدا. فأقل من 7٪ من الحروب على مر التاريخ البشري كانت دينية في طبيعتها وفقًا لموسوعة الحروب عام 2008 والتي فحصت ما مجموعه 1763 صراعًا عالميًّا.
وتكشف الأرقام الكثير عندما تنهار البيانات بفعل “الحضارة” ونشر نافيد شيخ، الأستاذ في جامعة لويزفيل، تقريرا بعنوان: “تعداد الضحايا: استعراض كمي للعنف السياسي عبر الحضارات العالمية” ، الذي بحث في الصراع في العديد من المجموعات الحضارية: المسيحية والإلحادية المنكرة للدين والبوذية والهندية والإسلامية والبدائية الأصلية، والصينية (شرق آسيا).
وباستعراض التاريخ، وجد التقرير أن الحضارة المسيحية كانت الأكثر دموية، حيث راح ضخيتها ما يقرب من 177 مليون شخص قتلوا في الصراعات والعنف السياسي بين السنوات صفر إلى 2008. وجاءت الحضارة “الإلحادية المنكرة للدين”، والتي تتكون في معظمها من الكتلة الشيوعية، في المرتبة الثانية كأكثر الحضارات دموية. واقتربت الحضارة الإسلامية من أسفل القائمة حيث قدر عدد ضحاياها بما يقرب من 31 مليون شخص، مما يجعلها ثاني الحضارات الأقل فتكًا بعد الحضارة الهندية، والتي كانت أقل الحضارات دموية.
في الواقع، ما يلفت النظر في تاريخ الشرق الأوسط هو النقص النسبي في الحروب الدينية. وهذا لا يعني أن الحروب التي كانت ذات دوافع دينية أو متأثرة بها كانت غير موجودة في الشرق الأوسط أو العالم الإسلامي ككل. بل كانت هناك حروب دينية ولكنها كانت أقل دموية وطولاً، وتكرارًا، لا سيما عند مقارنتها مع أوروبا.
ويقدر بعض المؤرخين، على سبيل المثال، أن سلسلة الحروب الدينية التي اندلعت في أوروبا الوسطى خلال عصر الاصلاح، والتي يشار إليها باسم حروب الدين (1524 – 1648)، قتلت نصف سكان ألمانيا. وعلى خلفية هذا العنف، بحث المفكر الإنجليزي التنويري البارز جون لوك (1632-1704)، في الإمبراطورية العثمانية كنموذج محتمل للتسامح في أوروبا. وفي صميم هذا التسامح كانت التعددية السياسية والدينية شائعة في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي.
باختصار، لقد كان تاريخ العالم الإسلامي منفصلاً عن العنف على عكس الأحداث المعاصرة في المنطقة الغارقة في العنف.
كيف وصلنا إلى هنا ؟ : العولمة
في كتابه، “ليس باسم الله: مواجهة العنف الديني”، استكشف الحاخام جوناثان ساكس الصعود الحديث للعنف الديني. مثل العالم السياسي، إريك كوفمان، الذي قال إنه يرى أن التحول العالمي العميق يمضي قدمًا، وأطلق عليه اسم “إزالة العلمنة” أو نهاية العلمانية. وأشار الحاخام ساكس إلى أن العولمة والتي هي المسئولة عن زيادة قوات “العلمانية”، مثلها مثل القومية، تتقادم بشكل متزايد.
فقد أضعف الترابط وسهولة انتقال البشر ورأس المال والأفكار من السيطرة التي كانت تتمتع بها الدولة القومية. وقد أبلى الدين، خصوصا الأصولية الدينية، بلاءًا حسنًا في هذا السياق لأنه يربط الناس معًا، بغض النظر عن أصولهم الوطنية أو الاجتماعية والاقتصادية.
وفي حين أن العولمة حولتنا إلى غرباء، فالدين حولنا إلى مجتمع. وفي الواقع، فإن الجوانب الإيجابية لهذا التحول الديني يشجع “إيثار الخير” وهو ما يعزز الثقة بين الغرباء، ويزيد من الرعاية الاجتماعية، ويعزز العدالة الاجتماعية، ويقلل من التوتر والصراع، وفي ربط الناس بعضهم ببعض يخلق مساحة للعمل الجماعي.
ومع ذلك، يوجد شكل آخر من أشكال الإيثار رائج بين الجماعات الدينية، وهو “إيثار الشر” كما يوضح الحاخام ساكس وإيثار الشر أيضا يربط الناس معا وإلا سيصبحوا غرباء. إلا أنه في نفس الوقت، يشجع على نوع من الإقصاء الذي يعامل “مجموعتنا” على أنها جيدة وأخلاقية بينما غيرها هو أهل الخطيئة والشر. ويقول ساكس إن هذه النظرة تتناقض مع الفكرة الأساسية الموجودة في الديانات الإبراهيمية القائمة على التوحيد (اليهودية والمسيحية والإسلام)، وهي أن الخير موجود داخل كل الناس.
تشجع العولمة نمو إيثار الشر والعنف عن طريق تشجيع الناس على الاعتقاد بأنهم يتعرضون للتهديد. وسيد قطب، المفكر المصري سيئ السمعة الذي عاش القرن العشرين، هو مثال ساطع على كيفية سير هذه العملية. فمن وجهة نظر سيد قطب أصابت العولمة والمادية الغربية مصر. فإن اعتماد هذه المعايير العالمية تقتل المجتمعات الإسلامية في النهاية، والتي كانت بطبيعتها “أفضل” إذا لم يفعل أحد أي شيء حيال هذا الوضع. ورأى قطب أن استخدام العنف “ضروري” لإنقاذ المجتمع المصري، والإسلام بصورة أعم، وهو رأي قامت عليه في نهاية المطاف جماعات مثل القاعدة وداعش.
كيف وصلنا إلى هنا ؟ : الاستعمار – القومية – الحداثة
ومع ذلك، يمكن أن تفسر العولمة جزئيا صعود الجماعات الدينية العنيفة في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. أما الاستعمار والقومية والحداثة فهي عوامل على نفس القدر من الأهمية في هذه العملية.
قبل عامين، كنت اعمل في محطة تلفزيونية في لندن وأجريت لقاءً مع يهود ذوي أصول عربية في أحد برامج الملامح. وفي هذا الإطار، التقيت إميل كوهين، وهو يهودي عراقي بريطاني. وكانت عينا السيد كوهين متسعتين وبراقتين وهو يتحدث حول العراق في شبابه وتذكر، بمزيد من الحزن ، كيف سحبت منه جنسيته العراقية بسبب عقيدته اليهودية، عندما كان طالبًا جامعيًّا في لندن.
ووفقًا للسيد كوهين، فإلى فترة الاحتلال البريطاني الثاني (1920-1932 و 1941-1958) كان العراق أحد أفضل الأماكن لليهود. ولم يكن الشعب اليهودي يعامل بالتسامح فقط، ولكنه كان جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الذي احتضنه. ونفى أن معاداة السامية كانت لها جذور عميقة في البلاد، وأصر على أن اليهود العراقيين من جيل أجداده لم يكونوا يدفعون الجزية.
ولكن تغيرت الأمور لليهود في العراق خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من الحكم البريطاني، حيث تنافست الحركات القومية وأصبحت معاداة السامية جزءًا من الخطاب السياسي في العراق. ويعتقد إميل أن البريطانيين شجعوا هذا، وذلك لتحويل الغضب الشعبي بعيدا عن الاحتلال.
في مقابلة مع قناة الجزيرة، أشار المؤرخ البريطاني وليام دالريمبل، إلى أنه أثناء الاستعمار وصعود الحداثة والقومية تم تدمير التعددية المنتشرة في الشرق الأوسط. فقبل الاستعمار، كانت المراكز الحضرية الرئيسية في جميع أنحاء العالم العربي والكثير من دول العالم الإسلامي متعددة الأعراق والثقافات وكانت أيضًا متعددة اللغات والأديان. وفي ظل النظام الاستعماري وما بعد الاستعماري، رفضت العقيدة القومية هذا التنوع وروجت لصورة جديدة من “التجانس” الثقافي والفكري واللغوي والعرقي.
وقد استعيرت هذه الأفكار من مشروع بناء الأمة في أوروبا القرن التاسع عشر، والتي تستخدم نهج “من أعلى إلى أسفل” لتجانس المجموعات المتنوعة في ثقافة وطنية فريدة. ويعد طرد اليهود من الدول العربية مثال جيد على كيفية عمل هذه القومية التجانسية في العالم الإسلامي، ومثله تمامًا معاملة الأكراد في سوريا والعراق وإيران وتركيا.
ومع ذلك، ففي نهاية المطاف، بدأت الجذور الاستعمارية للقومية العربية في السقوط.
في مقاله الذي نشر عام 1947 بعنوان ” الإسلام والغرب والمستقبل ” كتب المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي أنه عندما تقف الحضارات في مواجهة حائط فهي ترد بطريقتين: الهيرودية والزيلوتية.
وسعى الهيروديون – وهم القوميون المعاصرون في العالم الإسلامي، لتقليد الحضارة المهيمنة، أي الحصارة الغربية. ولأنهم كانوا مقلدين، فقد كانوا دائما أدنى من نظرائهم الغربيين وأقل فعالية في تحقيق أهدافهم. على وجه التحديد، فشلت الدول ذات الأغلبية العربية والإسلامية في التعامل مع الهيمنة الغربية ومرحلة ما بعد الاستعمار والعولمة، كما فشلت في تحقيق الاستقلال السياسي والثقافي والاقتصادي عن الغرب، مما نتج عنه خيبة أمل تجاه الأفكار الهيرودية وأدت إلى انبعاث الإسلام كقوة سياسية.
وعلى عكس الهيروديين، رفض الزيلوتيون (المتعصبون ) الحضارة المهيمنة صراحة، في جميع أشكالها. وتبنوا نهج المقاومة من أجل السيطرة، وتحولت العديد من الجماعات الإسلام إلى أداة للمعارضة وتحدي الوضع الراهن في الدول العربية والإسلامية. ومع ذلك فقد قامت هذه الجماعات بهذا في حين تعتمد أيضًا على الحداثة.
وبالنسبة للإسلاميين، فالحداثة شيء إيجابي، فهي تحمل مفتاح “تمكين” المسلمين. وكانت الحداثة الليبرالية في الدول الإسلامية ما بعد الاستعمار شكلاً “خاطئًا” من أشكال الحداثة. وبالنسبة للإسلاميين، فتقديم الحداثة البديلة، حيث استبدلت نظام الحكم القومي العرقي بآخر ديني، والذي كان ضروريًّا ومرغوب فيه.
ولأن العديد من أنظمة ما بعد الاستعمار في العالم الإسلامي تعتمد على العنف والقمع، فإن العديد من الجماعات الدينية التي نشأت لمحاربة هذه الأنظمة تحولت أيضا إلى العنف، اعتقادًا منهم أنه السبيل الوحيد لتحقيق بديلهم وهو نسخة جديدة الحداثة مستوحاة من الإسلام.
لا بد من الاصلاح
ليس صحيحًا أن الإسلام تطرف، ولكن التطرف تمت أسلمته، كما يقول أوليفر روي. وحين تكون هناك حاجة إلى الإصلاح، يجب إصلاح الحداثة، وليس إصلاح الإسلام، في ضوء عالم ما بعد الاستعمار المعولم.
لدى الإسلام إمكانات هائلة ليكون قوة للخير والسلام والمصالحة. ولكن، من أجل تحقيق هذا الإيثار الخيري، هناك حاجة ملحة لإعادة تقييم العولمة والاستعمار والحداثة. إن استمالة الخيرية المتأصلة في الإسلام لا تكفي وحدها، ما لم يتم تفكيك هذه الأيديولوجيات أيضًا.



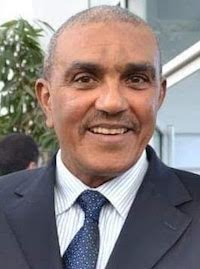

لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك