د. مصطفى
الشاوي
-
تمهيد:
أن تنجز قراءة نقدية في عمل فني مفتوح
وممتد شكلا ومضمونا، مغامرة عسيرة غير يسيرة، خاصة إذا كان هذا العمل ينتمي إلى
جنس الرواية المراوغ والمدهش على عدة مستويات، نظرا لطابعا التركيبي المتجدد،
وشكلها الحداثي المتشعب، ذلك الذي أصبحت تراهن عليه باستمرار، مما أتاح ويتيح لها
استقطاب أشكال أسلوبية، وأنماط تعبيرية، والانفتاح على مواضيع إشكالية معاصرة
كثيرة، وبطرق سردية جديدة، ووسائل فنية متعددة ومختلفة. على اعتبار أن
"التجديد الأدبي بحث دائب عن أدوات تمكّن الأديب، وتزيد من قدراته على
التعبير عن علاقة الإنسان بواقعه المتغير المستجد، وبهذا المعنى فإن التجديد في
الأدب هو – في التحليل الأخير – حيازة جمالية للعالم أو بحث عن عالم أفضل"[1]
وقد تغدو كل قراءة نقدية، لا تتخذ اللغة أساسا لها، ولا تقف عند مستويات الخطاب، تجانب
الصواب، وتنأى عن الموضوعية، لأنها تلغي، بوعي أو دون وعي، أهم مقوم تعبيري،
ومستوى لساني تستند إليه الكتابة الفنية، مع الإقرار، بأن لكل جنس أدبي مقوماته
الجمالية التي لا يستقيم بدونها. ثم إن العلاقة بينها أمر وارد في كل قراءة، ومعطى
طبيعي في كل جنس أدبي، لذا فمن الضروري أن يُنظر إلى كل مقوم في ذاته أولا، وفي
علاقته بغيره ثانيا. "ومعنى هذا أن الأدب ومنه الرواية يستثمر اللغة بكل
أبعادها ومعطياتها ويقحمها في صناعة جديدة هي صناعة الإنتاج التخيلي الذي يمثل
خطابا إيحائيا أو ترميزيا بامتياز، فتتعاظل فيه شفرة اللغة وشفرة الأدب ويصبح
الخطاب كثيفا ومركبا لا يمكن تبين بعض أبعاده ودلالاته إلا بمحاولة التعرف على بعض
مكوناته وسيرورة تكونه"[2]
من المعلوم أن مستويات الحكي، في معناها
العام، تشمل: الوظائف والأفعال والسرد، وبالرغم من أن الوظائف والأفعال ينتميان
إلى مستوى القصة، والسرد ينتمي إلى مستوى الخطاب، الذي يهتم بطريقة الحكي، فإنه
يجوز منهجيا دراسة كل هذه المستويات في ترابطها، ووفقا لنظام الإدماج المتصاعد. وعلى هذا
الأساس سننظر إلى الموضوع بالتركيز على الوظائف في علاقتها بمختلف مستويات الحكي،
على أن نعالجه من داخل الرواية، في ضوء أهم القضايا والإشكالات التي تعالجها، ومن
حيث علاقتها بثلاثة مقومات أساسية، هي الزمن والمكان والإنسان؛
واستنادا إلى هذه
المعطيات المنهجية والمعرفية سنتناول رواية (على إيقاع نهر الأحزان) للكاتب بوعزة
الفرحان[3]،
لأنها تنسجم مع هذا الطرح وتستجيب له. وهي أول رواية يصدرها الكاتب بعد إصداراته
المتعددة في مجال القصة والقصة القصيرة جدا والمسرح والبحث الاجتماعي والنقد
الأدبي، وهو الفائز بجائزة الدكتور نبيل طعمة بسوريا في القصة القصيرة سنة 2008.
مما يدل على أن الكاتب بوعزة الفرحان ولج عالم الرواية من باب القصة، ولم يحدث ذلك
إلا بعد أن اختمرت التجربة. والعمل المقروء وإن كان يندرج افتراضا ضمن الرواية
الواقعية (كما يؤكد الكاتب على ذلك في سياقات مختلفة، وكما تشهد على ذلك طبيعة
الأحداث والوقائع) لكنها واقعية من نوع خاص، لأنها مسجورة بفكر نقدي، أساسه
التحليل والمناقشة والسؤال، وليس همه نقل الأحداث، وتتبع الوقائع ومجرياتها بشكل
مباشر، مما يجعل القارئ أمام نسيج لغوي ومحكي ثقافي ومعرفي يمزج بين اللغة والرمز،
والعبارة والإشارة، والعقل والعاطفة في تناغم تام.
- في البدء كان الصراع؛
يمكن للقارئ أن يستشعر وظيفة الصراع بين القوى
الفاعلة بمعناها العام في الرواية بدءا من عتباتها الخارجية، أهمها متوالية
العنوان، ولوحة واجهة الرواية، وكلمة الراوي الأخيرة؛ وهو صراع داخلي تعكسه كل القوى
الفاعلة في ذاتها، وصراع خارجي تجسده في علاقاتها بغيرها من القوى المعاكسة. وإذا
كانت لوحة الغلاف تؤشر على صراع عام بين الموت (سواد، أشجار يابسة، أفق مضطرب..)
والحياة (وردة حمراء متفتحة، أوراق خضراء متناثرة، ضياء في الأفق..)، فإن بإمكان
القارئ أن يقف عند أشكال متعددة من الصراع في علاقتها بمختلف المقومات السردية؛
صراع الشخوص والأزمنة والأمكنة، صراع الأجيال والعقليات، صراع اللغات واللهجات
والعادات، ثم الصراع من أجل العيش الكريم والتنمية والكينونة والتحضر.
العنوان عتبة من عتبات الحكي ، ومستوى من مستوياته، لأنه ميثاق أساسي يربط
بين النص والقارئ؛ وتتألف متوالية العنوان من أربع كلمات، حرف وثلاثة أسماء، تشكل
جميعها شبه جملة، وقعت خبرا لمبتدأ محذوف، وعلى الرغم من أن مفردات العنوان واضحة
الدلالة في ظاهرها إلا أن العلاقة بين عناصره تولد تنافرا دلاليا، تؤسس لدلالات
تأويلية، استنادا إلى رمزية الكلمات، وتخلق انزياحا عن المعنى المتداول، بأن جعل
الكاتب للنهر إيقاعا وأحزانا، دلالة على سيرورة الأحزان وقوة وطأة أحداثها على القوى
الفاعلة المشكلة للعالم الروائي، وهيمنة الحزن على المحكيات، والطابع المأساوي
الذي من المحتمل أن تتسم به أحداث ووقائع الرواية. وتشكل جميعها محفزات قرائية.
وقد صيغ العنوان بطريقة محكمة ودقيقة. جعلته يضمر دلالات مختلفة، وهو ما يدل على
أن وراء اختياره مخاض عسير، تعكسه الرواية من داخلها؛ يشير الكاتب في سياق الحكي،
على سبيل الإشارة والإيحاء، إلى هذا الأمر، فيقول على لسان شخصية روائية أسندت لها
مهمة استقصاء قصة "حليمة" وتسجيلها: "لما كنت أقوم بالتحرير
الكتابي لهذه القصة العجيبة، احترت في اخيار عنوان لها، فعملت على صياغة عدة
عناوين تكون مناسبة لمضمون القصة. ومن بين العناوين المقترحة: "ما بعد
القصة"، "كم أنت قاس يا زمان"، "الحقيقية المقبورة"[4]. وهي
عناوين ضمنية تتقاطع مع عنوان الرواية (على إيقاع نهر الأحزان). ويعني هذا أن الكاتب
يتحدث من داخل الرواية عن رواية أخرى، وعن كاتب آخر. مما يتيح للرواية إمكانية
إعادة النظر في نفسها. يقول "بعد ثلاثة أشهر عرضت إحدى القنوات التلفزية فلما
تحت عنوان (مفترق الطرق). مع أن رواية الكاتب كانت تحت عنوان (بين التيه والضياع)
"[5]. وثمة
إشارات كثيرة تأتي في سياق الحكي تؤكد أن الكاتب وقف أمام بدائل كثيرة موازية
لعنوان الرواية، واختار أجودها، وهذا مؤشر أساسي من مؤشرات تعدد مستويات الحكي
داخل الرواية، وهو ما يمكن اعتباره تناصّا داخليا، ذلك أن فصول الرواية لا تخلو من
التصادي فيما بينها، فالحدث الواحد قد يحضر وفق مسرودات متباينة وفي سياقات
متباعدة. كل هذا، وغيره كثير، يجعل رواية (على إيقاع نهر الأحزان) حمالة رؤى
ومواقف وآراء وحكم وتحاليل ومطارحات وحقائق كثيرة.
تمتد رواية (على إيقاع نهر الأحزان) عبر ثلاث مائة وإحدى وأربعين صفحة من الحجم
المتوسط، وتشمل سبعة فصول، معنونة على الشكل التالي: ذكريات طفولة لا تنسى/ سعيد
الغوات/ هل الكافر يبكي/ قصة داخل قصة/ الحماة الصبيّة/ رجل القطار/ القصص التي لا
تكتمل في حينها/ كلمة الراوي الأخيرة. ونلاحظ أن هذه العناوين تؤطر ضمن ثلاثة
مجالات سردية، هي القوى الفاعلة (شخوص)، ونوع الخطاب (القصة)، وموضوع الخطاب
(ذكريات)، مع هيمنة الحقل الأول، مما يفترض التركيز عليه أكثر من غيره. كما أن
عناوين الفصول ركزت على نوعية الخطاب ومقوماته أكثر من التركيز على مضامين القصص
والمحكيات، وهي عملية مقصودة من الكاتب ليترك للقارئ باب الاجتهاد مفتوحا.
ويتألف كل فصل من مقاطع سردية مختلفة شكلا ومضمونا، وقد يتهيأ للقارئ، من خلال
قراءته الأولى لعناوين الفصول، أنها مستقلة عن بعضها البعض، وأنها نصوص قصصية تحقق
كل منها وحدتها، في حين أنها على خلاف ذلك، لما بينها من التداخل والاندماج، إذ لا
يمكن أن يُقرأ أيُّ فصل بمعزل عن الآخر، مع ضرورة التمييز بين القصة المركزية
والقصص الفرعية المنبثقة عنها. مع العلم أن الكاتب لم ينص تنصيصا واضحا على اعتبار
الأجزاء فصولا، وترك الحرية للقارئ، ليدرك ما تنافر منها وما ائتلف، وهو رهان من
الرهانان الأساسية التي تواجه القارئ.
وتتمحور القصة الأم، التي تتناسل
منها عدة قصص، حول قصة سمية، الفتاة التي ازدادت في قرية "مرشانة" نواحي
مدينة تاونات، شمال المغرب، في ظروف غامضة، تجد نفسها في كنف جدتها خدوج، أخفت
عنها حقيقة ميلادها. وبعد أن ضاقت الحياة بالقرية بفرار العبدي، وارتكابه لجرائم،
ومتابعته من طرف السلطات، وتتعمق المأساة بهجرة سمية، بعد قصة حبها لعمر، وتعذر
زواجه بها، لخضوعه لأخيه، تسافر إلى "كريان السعيدية" ضواحي مدينة مكناس.
وهو حي هامشي يهاجر إليه سكان القرى. وتعمل خادمة عند أسرة ميسورة. حيث يحالفها
الحظ فتتزوجُ الحاجَّ الذي كانت خادمة له، بعد موت زوجته على إثر مرض عضال، وتتحسن
حالتها الاجتماعية والاقتصادية، وترزق من الحاج بابنها عمر. ويموت زوجها الحاج
فترث ممتلكاته. لكنها تظل طول حياتها تبحث عن أمها وأبيها، وطول فصول الرواية
تتساءل عن هويتهما. فتسافر إلى مدينة آسفي وإلى قبيلة عَبْدَة تحديدا، متفقدة أثرهما،
لكنها ترجع خائبة. وتدور دوائر الزمن وتمتد، فيتزوج ابنها سعد بكوثر، تكتشف أنها
ابنة عمر الذي أحبته في قرية "مرشانة"، عمر الذي لم يتزوج إلا بعد أن
يئس من البحث عنها. وتنتهي الرواية نهاية مأساوية، بانتحار حليمة التي أبت إلا أن
تضع حدا لحياتها بقريتها، وتحضر سمية جنازتها دون أن تعلم أنها أمها التي ولدتها
في علاقة غير شرعية بأبيها العبدي. الذي سيرجع بدوره إلى القرية، بعد أن غادرها كلُّ
من كان يعرفه من قبل، وذلك بعد أن ندم على كل ما اقترفه، ويحاول عبثا إصلاح ما فاته.
-
التحفيز الداخلي والخارجي:
المكان محفز على
الحكي، ورافد من روافد السرد، ودافع من دوافع البوح، لما له من أثر في الوجدان،
ووشم في الذاكرة، وترسخ في الذهن، فهو مسرح الحياة وميدانها، وشاهد حيٌّ وعادلٌ
على وقوع الأحداث عبر الزمن، وعلى ما يعيشه الإنسان ويكابده، ويعانيه من أجل تحقيق
آماله، وإثبات ذاته ووجوده. وهو في نفس الآن معاينٌ لمعاناته في صمت وخشوع. وعلى
هذا الأساس فالمكان قوة فاعلة لا تقل أهمية عن غيرها من القوى الأدمية، مادام
فاعلا في الحكي ومهيمنا عليه. والملاحظ أن تنوع الأفضية والأمكنة العامة والخاصة
في الرواية ساهم في إغناء مرويات فصولها، وإمدادها بحمولة فكرية، مشفوعة بالسؤال،
وممزوجة بالوصف، ومدعومة بالحوار، القائم على استنطاق أسرار الحكي، والكشف عن
مواجده وأشجانه.
وتراهن
الرواية على أن كل شيء متغير، ولا شيء يظل ثابتا في كل زمان ومكان، وهو ما يترصده
الكاتب، ويثبته بالدليل والحجة، من داخل المحكيات المشكلة للمتن الروائي، بل يمكن
اعتبار هذا القانون محفزا على الحكي، إن لم نقل بأنه المحفز الأساس الكامن وراء
كتابة الرواية، مع العلم أن ثمة حوافز أخرى فنية وجمالية تنسجم وخصوصيات الجنس
الروائي في منظور الكاتب بوعزة الفرحان. يقول "الحياة لا تعطينا دائما ما نريد"[6]،
و"لا أحد يعيش في الدنيا وهو راض عن حياته"[7]،
و"الحياة تتحرك في دورات عجيبة لم تخطر على البال"[8]. وهكذا
يتبين أن من عوامل التحفيز الداخلي على الحكي كون الكاتب بوعزة الفرحان ويمتلك ذاكرة
قوية، ومعرفة واسعة، بل وخبرة ميدانية بالواقع الذي يحكي عنه وكأنه جزء منه. ويتجلى
ذلك من خلال التفاعل المباشر مع شخوصه، وهي تعيش تجاربها المرة، فيصور الكاتب
الراوي وكأنه داخل المحكيات، مجسدا لدور من أدوارها، بشكل ضمني، أو صريح. مما يدل
على أن جل شخوص الرواية واقعية وليست محض خيال، وإن كان حضورها داخل العالم
الروائي يمنحها بعدا فنيا.
ولا
تخفى على القارئ اللمسة الفنية للكاتب، يبدو ذلك جليّا في العناية الفائقة بالشخوص،
بدءا من تسميتها تسمية دقيقة، تحيل عليها وحدها دون غيرها، مع عدم إغفال تسمية أي
منها، حتى وإن تقلص دورها، أو ظهرت في سياق الحكي بشكل عابر. ولا يقف الكاتب عند
الاختيار الأمثل للتسمية فحسب، وإنما يمنحها حظوة كاملة، وينزلها المقام الملائم
الذي هُيِّئت له، مع الغوص في عوالمها الداخلية، والكشف عن هواجسها وآمالها
وأحلامها ومعاناتها، يفرح لفرحها، ويحزن لحزنها، راصدا هواجسها النفسية، وأبعادها
الاجتماعية، ومضمراتها الثقافية. مما يجعل منها نسيجا محوريا، مشكلا لمحكيات
الرواية ومهيمنا على متنها السردي؛ ويستشعر القارئ أن الكاتب يولي اهتماما
كبيرا لكل قوة فاعلة تظهر على مسرح الأحداث، ولا يقتصر ذلك على الرئيسي منها دون
الثانوي والعابر، وهو ما يؤكد على أهمية البعد الإنساني العائلي والأسري، بل والمجتمعي
القائم على أواصر القرابة، والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات، ومدى
التطور الذي عرفه ويعرفه النسيج العائلي عبر الزمن التاريخي، الذي بدأ يعاني من
مجموعة من العوائق التي تحول دون استمرار التماسك الذي كان حتى حين يشكل مصدر قوة
ووحدة، وعِزّة وكرامة، وثبات واستمرارية.
وفي هذا السياق نلاحظ أن الرواية تغطي مرحلة زمنية
طويلة تستوعب أربعة أجيال: جيل الأجداد، وجيل الآباء، وجيل الأولاد، وجيل الأحفاد،
مع تركيز الحكي على جيلين أساسيين الآباء والأولاد، وتأتي الإشارة إلى باقي
الأجيال على سبيل استرجاع الماضي أو استشراف المستقبل؛ وتصور الرواية الحياة كخشبة
مسرح تجسد فيها كل قوة فاعلة دورها الوظيفي المحدد في الزمان والمكان، وفي صراع مع
الآخر، وتنسحب بعد حين، لتعتلي الخشبة شخوص أخرى. وهكذا دواليك. مؤكدا على حقيقة
كون "كل إنسان لا يستطيع السير مع الزمن، لكن الزمن قادر على أن يسير دونه"[9]. وهو ما
يؤكد قوة وظيفة الزمن، وغرابة أطواره. ولم يكن الراوي، فيما يبدو، في حاجة إلى
البحث في مختلف المواضيع التي تتناولها الرواية، قصد التزود بالمعارف والمعطيات
والأفكار، كما قد يلجأ إلى ذلك كتاب كثيرون، وذلك لاعتبارات عدة، لعل أهمها كونه
عالِماً بالفعل بأسرار الشخوص، ومجريات الأحداث، وحقيقة الزمان والمكان.
ومن وجهة أخرى، يمنح المكان للرواية بعدها الواقعي والفني؛ فجل الأماكن
التي احتضنت الأحداث، وكانت شاهدة على وقوعها عبر الزمن، تحمل أسماء تحيل عليها في
الواقع، وهي أسماء مدن، وقرى، ودواوير، وأحياء، ومرافق، ومؤسسات، وفضاءات وغيرها،
وقد عمد الكاتب إلى تنويع الأماكن، مما أتاح للمحكيات حركية، وللقصة دينامية تجعل
القارئ في انشداد مستمر إلى سيرورة الأحداث وعلاقتها بالأمكنة، سواء العامة كالقرى
والمدن، أو الخاصة كأسماء الأحياء والربوع والمنازل والديار.
-
سيرورة الزمن والتحول:
يحضر الزمن في الرواية على مستويات عدة، ليس باعتباره مكونا فنيا فحسب، أي وعاء
ظرْفيا محتضنا للأحداث وشاهدا عليها، بل كملفوظ لغوي يُسنِد إليه الكاتب الأفعال
أو ردود الأفعال، مما يجعله يحظى بمكانة أثيرة في المتخيل السردي للرواية،
ولمحكيات بوعزة الفرحان، ويشكل قوة فاعلة في تجسيدها، ويساهم في تحريكها بشكل مستمر،
وقد يمثل عاملا مساعدا أو معاكسا، مما يمنحه قيمة. وغالبا ما يأتي مرادفا ودالا
على الحياة. وتارة يأتي مرادفا للفوضى، لصعوبة التحكم في مجرياته. ويتم التعبير عن
هذا الأمر بملفوظات سردية مختلفة، تساق على لسان الشخوص، من قبيل قول السارد، "تحول
الزمن في القرية إلى فوضى تجري وراء الظلال"[10].
عمد الكاتب بوعزة الفرحان إلى التعامل مع
الأحداث الواقعية باحترافية وتبصّر، فوقف عند الكثير منها بدقة، وسكت عن البعض
منها بشكل قصدي، رغبة منه في تحفيز القارئ على البحث عن الحقائق الضائعة، وكشف
أسرار الحكي، وجعل المتلقي عنصرا فاعلا داخل النص السردي، ومشاركا في تشييد الرؤى؛
"فالكاتب يعرف حقيقة الظروف التي ولدت فيها "سمية"، كيف أطلت على
الحياة، لكنه ساهم في تعتيم الوضعية، وإخفاء الحقيقة عنها، للدفع بها في عالم من
الفوضى، لا يستقر على حال، وهو ما جعلها باستمرار تسأل نفسها عن أمها وأبيها، مما
يعمّق أزمتها، ويُبْقى القارئ طول الرواية في سيرورة تشويق مستمر. وبذلك خلق منها
الراوي "بطلة تقوم بدور ذلك المُحَقّق المبتدئ في عمله، وقد ساعدها القارئ
على إزاحة السّتار عن تلك الأوراق السرية للحدث عن طريق فحص الأحداث الماضية بدقة،
وركوب متاهة التخمين والتأويل."[11]
يصعب أن نتمثل الزمن في الرواية وفق نمط محدد سلفا، لأنه مفهوم متغيّر ولا يستقر
على حال، كغيره من مكونات السرد، إذ يعتمد على منظورات متباينة، كما لا يتخذ لبوسا
واحدا، ولا لونا معينا، بل يتشكل كالحرباء، ومن ثمة يلاحظ القارئ حضور مرويات
عديدة ومتداخلة تداخلا معقدا؛ وعموما، يمكن أن نميز بين زمن القصة، وينفتح على
الماضي والحاضر والمستقبل، وزمن الحكي وهو الحاضر، لكنه حاضر متعدد لأنه يستشرف
المستقبل ويعود إلى الماضي، وهو ما يجعل القصة متشعبة استنادا إلى التفاعلات المتداخلة
للزمن.
المستوى
الفكري من أهم مستويات الحكي في الرواية، ينتهي إليه الحكي في سياقات كثيرة، ولا
يقتصر على موضوع من المواضيع التي تتناولها الرواية، بل يصاحب كل مراحل الحكي، بمختلف
مجالاته، ويتلبّس كل مساربه؛ ومن الأمثلة الدالة على ذلك، إخضاع شخوص الرواية إلى
المساءلة وانشغالهم بها؛ من قبيل قول الكاتب "هل كان العبدي رجلا أصيلا؟ هل فَعَلَ
خيْراً في المكان الذي حل به طريدا شريدا... ؟ هل تحرّك ضميره نحو الندم؟ وهل لام
نفسه على فعلته؟ هل فكر في إصلاح نفسه؟ هل فكر في مصير ابنته عندما تكبر؟"[12].
وكلها أسئلة غير مقصودة في ذاتها، وإنما غايتها تحليل الشخصية، والوقوف عند تركيبتها
النفسية الغامضة والمعقدة. وهكذا تفرز ضفيرة الْقَصِّ مستويات حكائية عدة، أهمها
المراوحة بين السرد والوصف والحوار والتحليل مما يؤسس لمسرودات متشاكلة ومتباينة.
ونظرا لتعدد إيقاعات الحكي، يعيش القارئ مع حكي حركي، لا يستقيم على إيقاع واحد،
وانسجاما مع طبيعة الأحداث التي تعالجها الرواية، والتي نجدها تجمع الإيقاع التراجيدي
الحزين والمضطرب، وهو الغالب على جل الوقائع، والإيقاع الوجداني الساكن والهادئ،
ويحضر حضورا عابرا. والملاحظ أن الحكي الحزين يمتد إلى اللحظات الجذلى التي تراود
شخوص الرواية، بين الفينة والأخرى، ويشعر بها القارئ، كما يصرح بها الكاتب تصريحا
واضحا، في سياقات كثيرة، من قبيل قوله: " كان الرجل يحكي برنة الإنسان
الحزين"[13].
وهو ما يدل على أن الإيقاعات الحزينة تهيمن بالفعل على الرواية، انسجاما مع منطوق
العنوان.
أعطى الكاتب للراوي اسما، كما يؤشر على ذلك الفصل الأخير من الرواية، والذي جاء
تحت عنوان "كلمة الراوي الأخيرة"، وذيل هذه الكلمة بعبارة "الراوي
سعيد الغوات"، وهو الاسم الذي عنون به الكاتب الفصل الثاني من الرواية
"سعيد الغوات"، ويحيلنا هذا العنصر على قوة فاعلة أساسية في الرواية،
ويدل على أن الكاتب حسم في اسم الراوي، ليوهم القارئ بالحياد، وليكسب الحكي طابعه
الموضوعي، ويتخلص من الاعتبارات الذاتية؛ وبذلك استطاع الكاتب بوعزة الفرحان أن
يدمج الذاتي في الموضوعي، بطرق فنية مختلفة، ومنها مثلا حديثه عن كاتب الرواية من
داخلها، بأن خلق كاتبا يعرف كل شيء عن حكاية "سمية"، ويتتبع قصتها
ويتحرّى تفاصيلها، تلك القصة التي ستتخذ شكلا روائيا، ويتم إخراجها في شريط سنيمائي،
كما جاء على لسان الراوي في الرواية.
ويغوص الحكي في رصد صراع الإنسان، عبر الزمان والمكان، وعلى أصعدة متعددة،
وخاصة تلك التي شهدها المجتمع المغربي، حين خضع بدوه إلى سيرورة التطور سلبا
وإيجابا، تتجسد في تحديات كثيرة واجهتها الأسر الفقيرة والمتوسطة، وعبر فترة عُرفت
بالاضطهاد والقمع والاقصاء، وجعلت الانسان البسيط يعيش صراعا مستمرا، من أجل نيل
الحرية، ومواجهة جبروت الاستعمار، وسيطرة الاقطاع، والتبعية، والهيمنة، والهجرة،
والتخلف، والتطرف، والعولمة..؛ "أجيال جديدة ولدت تحت القهر والذل والمهانة..
"[14]. ويقف الحكي عند أهم المثبطات والمعتقدات
التي حالت دون التحرر العقلي والفكري والنفسي، يقول منتقدا وساخرا من بعض
المعتقدات والأعراف السلبية؛ "لم تنفعني الزيارات التي كنت أقوم بها إلى قبر "سيدي
بوعْعِيّة": لقد أدركت الآن أنه "سيدي بوخْطِيّة" وليس سيدي
بوعطية، ما رأيته أعطى لأحد شيئا"[15].
وتستحضر الرواية - تصريحا وتلميحا- مرجعيات مشهورة، وقصص ونصوص وأساطير تأثر بها
الكاتب بوعزة الفرحان، وتفاعل معها بشكل أو بآخر. كما تتفاعل الرواية مع نصوص
غائبة كثيرة ومتنوعة؛ ومن أمثلة التفاعل الصريح الإشارة إلى رواية (بداية ونهاية)
لنجيب محفوظ، في قول الراوي: "فأحسست أني أقرأ رواية (بداية ونهاية) لنجيب
محفوظ"[16].
ومن أمثلة التفاعل الضمني، الإشارة من خلال ملفوظ سردي إلى أسطورة "أوديب" في الميثولوجيا
الإغريقية؛ يقول الكاتب متحدثا عن العبدي في لحظات عتاب النفس على أفعاله، "فكلما
تذكر جرائمه وجدها أقل بكثير من جريمة اغتصاب أمه وقتل أبيه، وتشريد أخيه الذي لم
يعرف مكانه"[17].
وهو ما يؤكد أن الصراع هو التحدي الصعب، والقضية المحورية المهيمنة على مرويات
الرواية، على عدة مستويات دلالية وفنية، من حيث علاقتها بالإنسان في الزمان
والمكان، وبالموت والحياة، وبالحكي بين الماضي والحاضر والمستقبل. ووفق رؤية سردية
وفكرية تصدر عن قناعة منطقية مفادها أن لكل شيء بداية وسيرورة ونهاية.
نخلص إلى القول، إن رواية (على إيقاع نهر الأحزان) متعددة المرويات والمرجعيات، الفكرية
والتاريخية والثقافية والاجتماعية والتربوية، وقد اعتمد فيها الكاتب على خطة سردية
مركبة، استندت إلى أساليب مختلفة، كالحكي والوصف والحوار، والتحليل والتعليل والنقد،
وتَمَّ التوليفُ بإحكام بين الرؤية السردية من الخلف والرؤية من الداخل، وقد أدى
فيها السرد وظائف متباينة، أهمها التحول والصراع والتحفيز، وراهن فيها المحكي
الروائي على إيقاعات الحياة، باعتبارها تجربة وجودية صعبة ورحلة شاقة وعسيرة، غير
قابلة للتأطير الدقيق والمسبق، لعدة إكراهات، في علاقتها بثلاثة عناصر متغيرة
ومنفلتة ومعقدة، هي الإنسان بأطيافه وألوانه ومحفزاته، والزمن بدوائره وتشعباته
وامتداداته، والمكان بأحداثه وأوجاعه وذكرياته.
[1] ـ شكري عزيز
الماضي، أنماط الرواية العربية الجديدة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد 355،
شتنبر 2008 م، ص11.
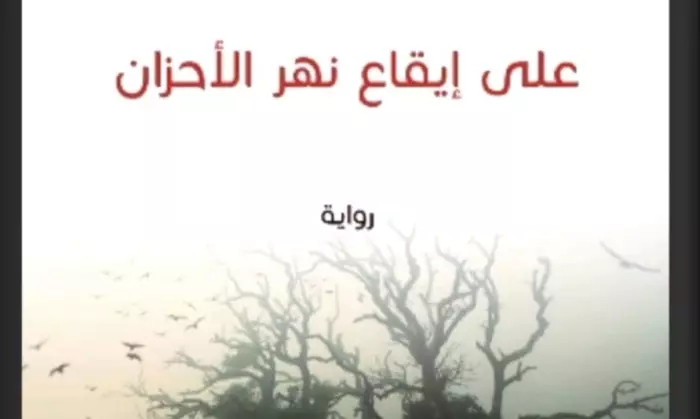
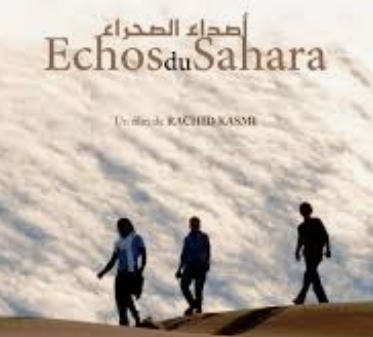
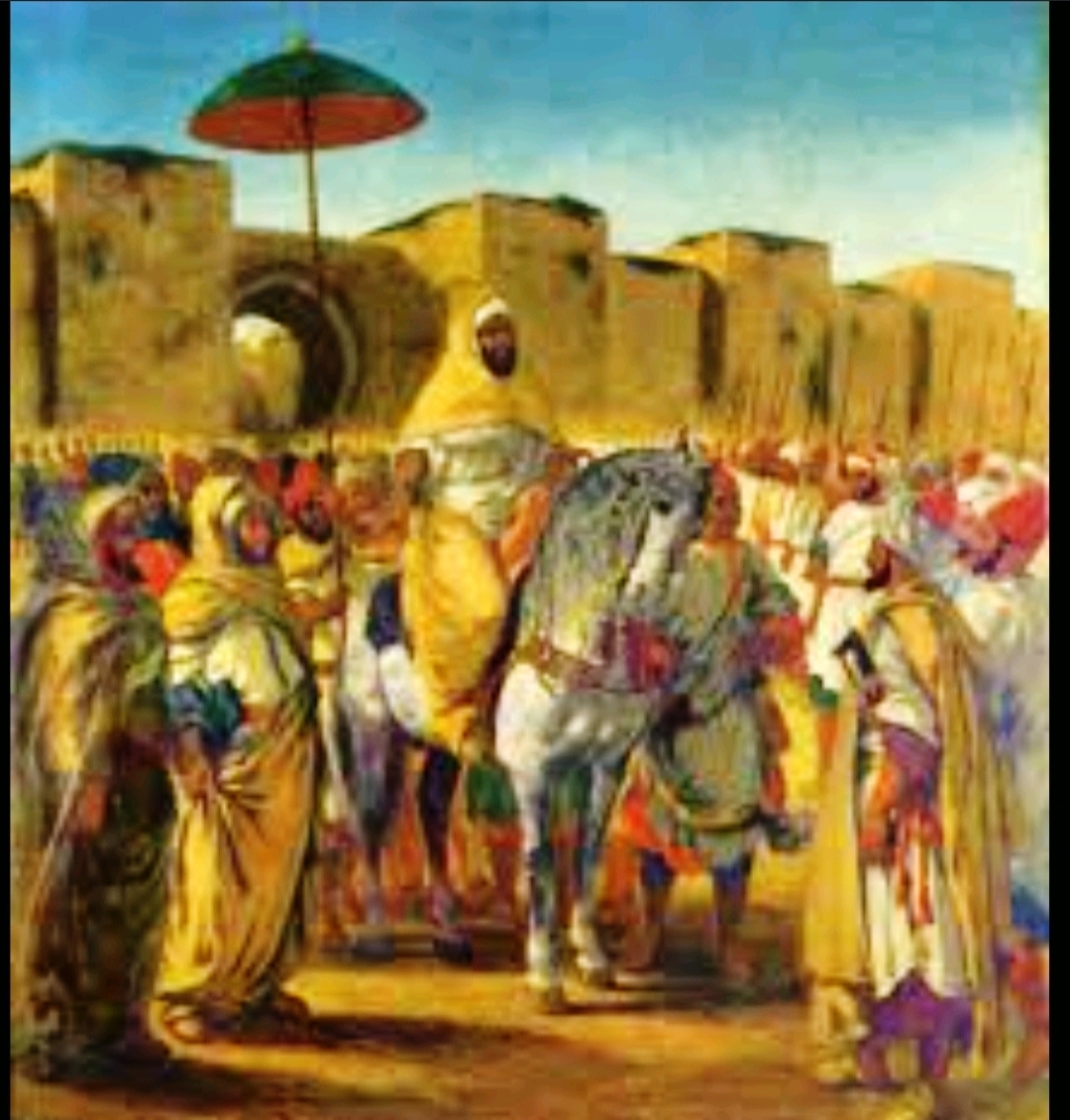

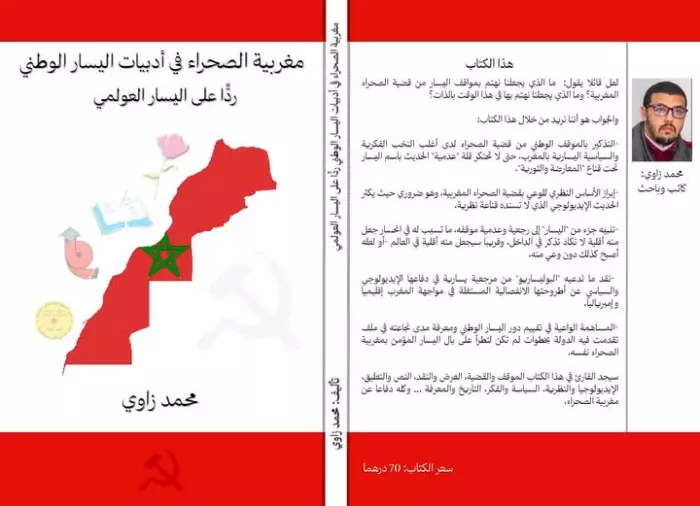
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك